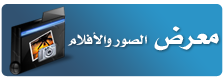الأخــبــار
دخول الأساتذة
| آليات تدبير الاختلاف بين "الفقه" والمؤسسات التشريعية الحديثة | ||

في سياق مشروع البحث العلمي لمؤسسة دارالحديث الحسنية الذي اختير له هذه السنة موضوع "تدبير الاخـتـلاف في الـمجال الإسـلامـي"، نظمت المؤسسة مائدة مستديرة في موضوع: آليات تدبير الاختلاف بين "الفقه" والمؤسسات التشريعية الحديثة، يوم الخميس 10 دجنبر 2009 بمقر المؤسسة، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمفكرين من داخل المغرب وخارجه.
ويندرج موضوع هذه المائدة المستديرة ضمن الشواغل المعرفية التي تشتغل عليها مؤسسة دار الحديث الحسنية، وتستدعي نقاشا وحوارا حقيقيين وجادين؛ في أفق بناء تصور حول موضوع ازدواجية تقرير الأحكام المنظمة للمجتمع ولعلاقات التعايش بين أفراده، وإنهاء آثاره السلبية.
ومن المؤكد أن ما يساعد على حل هذا التعارض بين الفقه ووسائل التشريع الحديثة هو استعراض ومناقشة العناصر المعتمدة لدى الفقه ومؤسسات الدولة الحديثة في تقرير الأحكام وما بينها من اختلاف. من حيث المرجعية والجهة المختصة بالتقرير وطبيعة الحكم المقرر.
وفي هذا السياق تطرح جملة من الأسئلة المحورية، من قبيل:
*إذا كان الاختلاف واقعا في المرجعية وفي جهة الاختصاص ثم في طبيعة الحكم المقرر، فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ثابتة ومؤكدة لا سبيل إلى تجاوزها؟ أم أن الموضوع قابل للنقاش ويعد مجالا لتقديم أفكار تذيب الاختلاف؟
*هل هناك مقترحات تساعد على جعل مضامين القوانين والتشريعات محققة لمصالح المجتمع من جهة ومرتبطة بنصوص الشريعة من جهة ثانية أفضل من واقعها الحالي؛ سواء كانت هذه المقترحات تتعلق بالإجراءات العملية أو بتشكيل واختصاصات المؤسسات المسندة إليها صلاحية إصدار القوانين؟
*هل في الإمكان سن إجراءات للاعتراف بصفة "مجتهد" مع الالتزام بآثارها المتداولة في أصول الفقه وفي مقدمتها وجوب الاقتداء به من جميع الذين لم يُعتَرف لهم بهذه الصفة؟
*هل يكون اختصاص هذا المجتهد عاما في جميع مرافق المجتمع وحاجياته المختلفة؟ أم يكون قاصرا على جزء منها؟
*هل الحل كما طرحته بعض المقترحات هو إسناد مهمة الاجتهاد أو التشريع إلى "مجمع" من العلماء أو الراسخين منهم، أو باشتراك مع متخصصين آخرين في كل دولة إسلامية أو على مستوى العالم الإسلامي؛ لكن يبقى كيف يتحقق ذلك، سواء في كيفية تحديد "العلماء" أو "الراسخين" أو ذوي الاختصاصات الأخرى؟ ومن يفصل في هذا التحديد؟ وهل بعد تكوين "المجمع" تلغى السلطتان التشريعية والتنفيذية الموجودتين حاليا في الدولة الحديثة ؟ أم يوزع الاختصاص بينهما وبين المجمع؟ ومن يتولى هذا التوزيع؟ وكيف؟
تلكم جملة من الأسئلة والإشكالات التي حاولت المائدة المستديرة وضعتها أرضية للنقاش وتبادل الآراء، فاجتهد المتدخلون في مقاربتها من زوايا مختلفة من خلال محورين:
المحور الأول: الاختلاف وعناصره
1-عنصر المرجعية:
فيما يخص قضية المرجعية فإن أغلب التدخلات أشارت إلى الاختلاف بين مرجعية الفقه التي تستند إلى النصوص الدينية (القرآن والسنة) والمصلحة مع الاختلاف في تحديدها، وبين مرجعية القوانين التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات المختصة في الدولة الحديثة حسب كل ظرفية وإكراهاتها بناء على مصلحة المجتمعات ومتطلباتها.
كما أثارت بعض التدخلات الإشكالات المنهجية المتعلقة بمرجعية الأحكام الفقهية، فإذا كان مصطلح "الفقه" يشمل "فقه العبادات" و"فقه المعاملات" الذي يشمل كل المجالات التي ينظمها"القانون" بمعناه العام في الدولة الحديثة، فإن منهج البحث فيهما يبقى منهجا واحدا يختزله علم "أصول الفقه". لكن الواقع يشهد بأن الفقهين ليسا من طبيعة واحدة؛ فالعبادات أحكامها تعبدية أساسا، واستعمال "العقل الفقهي" (الاجتهاد) فيها محدود جدا ويقتصر على جزئيات تفصيلية، عكس فقه المعاملات الذي وردت فيه نصوص قطعية الثبوت (القرآن ومتواتر السنة) عامة الدلالة، ونصوص مقررة لمصلحة ظاهرة يمكن أن يتغير حكمها إذا فقدت المصلحة التي شرع من أجلها وفقا للقاعدة الأصولية "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، الأمر الذي يؤكد بأن كثيرا من أحكام الشريعة مصدرها القاعدة الشرعية "درء المفاسد وجلب المصالح"؛ سواء استندت إلى نص خاص ظني الدلالة والثبوت أو إلى نص عام. لكن الإشكال الذي يطرح في هذا المضمار هو: كيف تتحدد المصلحة أو المفسدة في التصرف أو الواقعة حتى يصاغ الحكم المناسب لها؟
وبالمقابل فإن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات المختصة في الدولة الحديثة تهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح المجتمع الذي تمثله، والأسس النظرية التي أقيمت عليها.
ومع ذلك لاحظ كثير من المتدخلين أن الاختلاف في المرجعيتين (أي مرجعية الفقه والقانون) لا يعدم قواسم مشتركة بينهما؛ سواء فيما يتعلق بالجانب المسكوت عنه في الشريعة الإسلامية (وهو ما يصطلح عليه ذوو الاختصاص بمنطقة العفو التي يحتكم فيها غالبا إلى المصلحة)، أو ما يخص الجانب الإنساني المشترك (المتمثل في العقل والفطرة والتجربة والعرف...).
1-الجهة المختصة بالتقرير:
أما مسألة الجهة المختصة بإبداء الرأي فإن أبرز الاختلافات التي أثارتها بعض التدخلات فيمكن إجمالها في ما يلي:
إن المتتبع للأدبيات الفقهية التي تناولت هذا الموضوع سيلاحظ أن ثمة جهتين للتقرير: الإمام أو الخليفة من جهة، والمجتهد من جهة ثانية. فالإمام أو الخليفة يقرر فيما أسند إليه من "تدبير المصالح العامة للأمة" وهي عبارة تشمل بعمومها كل ما يهم تنظيم مرافق المجتمع ومصالحه. في الحين الذي يقرر فيه المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي سطرها الأصوليون في الأحكام المتعلقة بالأفراد. ولكن بوقوفنا على الواقع العملي سنجد - كما لاحظ بعض المتدخلين- أن المجتهد وحده المختص بتقرير جميع الأحكام المنظمة لحياة الفرد والمجتمع؛ سواء كانت مستندة إلى تفسير نصوص خاصة أو إلى النصوص العامة ومبادئ الشريعة وكلياتها.
وتقرر في هذا المجال أيضا أن حق الاجتهاد مكفول لكل من له الأهلية لذلك، لكن الصعوبة تكمن في تعيين المنطقة الحدية التي تفصل بين "المؤهلين" لإبداء الرأي وبين عديمي الأهلية الذين يتوفرون على معرفة ولكن لا تؤهلهم للاجتهاد، كما طرحت في هذا السياق فكرة المجامع الفقهية أو المجالس العلمية كفكرة بديلة لفكرة المجتهد الفرد.
وبالنسبة للدولة الحديثة فالمؤسسات التشريعية تجري فيها الأمور على نحو مختلف يراعي مصالح المجتمع والأسس النظرية والفكرية التي يقوم عليها نظام التشريع حيث تصنف القواعد الملزمة في تنظيم المجتمع إلى دستور، وقوانين، ونصوص تنظيمية؛ فالدستور يشترك جميع أفراد المجتمع في تقريره عن طريق الاستفتاء، أما القوانين فيعهد إصدارها إلى المؤسسة التشريعية المتمثلة في البرلمان، أما السلطة التنفيذية أي الحكومة فتبقى لها صلاحية النصوص التنظيمية.
2-عنصر طبيعة الحكم المقرر:
أهم الإشكالات التي طرحت بخصوص هذا العنصر:
إن حديث الفقهاء عن الدولة كان حديثا عن الأشخاص الموكول إليهم أمر تسيير مؤسسات الدولة كالخليفة أو الإمام ولم يعالج أبدا طبيعة مؤسسة الدولة أو نظم تدبير أمورها، فهم المخاطبون بممارسة حقوق الدولة وأداء التزاماتها، والمؤسسات المعبر عنها بالولايات الشرعية تتشخص كذلك في هؤلاء الأفراد؛ أما اليوم وقد تغيرت وتطورت فلسفة المجتمع الإنساني وأفكاره إزاء مفهوم الدولة وتنظيمها، فقد برزت تخصصات قانونية ، مثل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي وغيرها من القوانين التي تسعى إلى تنظيم كافة ميادين النشاط البشري بالإضافة إلى مجموعة من النظم مثل النظام الجبائي والنظام القضائي ونظام المركزية واللامركزية، ونظام المؤسسات العمومية وغيرها من النظم التي تعنى بتنظيم الدولة ومؤسساتها.
كل هذه الموضوعات وغيرها كثير، ما تزال غائبة في الدرس الفقهي الذي لا يساهم في مناقشتها وتنويرها، ولا يقدم بديلا قابلا للتطبيق ويكتفي بنعتها بـ"القانون الوضعي" المخالف لشريعة الإسلام بما يترتب على ذلك من تداعيات .
ومن الإشكالات كذلك التي طرحت خلال مناقشة هذا العنصر طبيعة الرأي الفقهي الذي يتوصل إليه المجتهد عن طريق الاجتهاد؛ إذ أضحت الأحكام الاجتهادية مع مرور الزمن تتصف بالثبات والاستمرار مما يجعل تلك الأحكام الصادرة غير قابلة للتجديد (وهذا عكس ما أكده الأصوليون من أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ووجوب مراعاة المآل في تقرير الأحكام ….)
أما بالنسبة لمؤسسة الدولة، فإن ما تصدره من تشريعات قانونية وتنظيمية قابلة للتعديل والإلغاء، لذلك كانت القوانين سريعة التعديل والإلغاء.
وخلاصة ما ورد ضمن هذا العنصر هو ضرورة التمييز بين الأحكام الثابتة التي لا تخضع لتغير الزمان والمكان (كالأحكام المتغيرة) والأحكام التي تخضع لسنة التغيير (كالأحكام المعاملاتية). ويبدو أن مسألة الوضعية المؤقتة أو الأبدية للأحكام لم تتبلور فيها تصورات واضحة.
المحور الثاني: تدبير الاختلاف
أما المحور الثاني من المائدة المستديرة فقد حاول تقديم بعض المقترحات لتدبير هذا الاختلاف؛ بمعنى، إذا كان الاختلاف أمرا واقعا في المرجعية وفي جهة الاختصاص ثم في طبيعة الحكم المقرر، فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ثابتة ومؤكدة ستبقى دائما عائقا لتجاوزها؟ أم إن الموضوع قابل للنقاش ويعد مجالا لتقديم أفكار تقلل من مسافة الاختلاف وإن لم يتم تذويبها؟
ويمكن إجمال ما قيل حول السبل والوسائل الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات فيما يلي:
1-المرجعية :
على مستوى المرجعية لاحظ بعض المتدخلين أن درء المفاسد وجلب المصالح هو الذي يشكل المرجعية الأساسية والعليا في تفسير نصوص الشريعة واستخلاص الأحكام منها، وأن هذه القاعدة تبقى الهدف نفسه من تشريع القوانين الوضعية.
كما اقترح المتدخلون جملة من المقترحات تساعد على جعل مضامين القوانين محققة لمصالح المجتمع ومرتبطة بنصوص الشريعة أفضل من واقعها الحالي؛ سواء كانت المقترحات متعلقة بالإجراءات أو بتشكيل واختصاصات المؤسسات المسندة إليها صلاحية إصدار القوانين..
2- المصدر أو الجهة المختصة بالتقرير:
في ظل الواقع المعاصر كاد أن يحصل الاتفاق بين جميع المتدخلين أنه لم يعد مقبولا في تنظيم المجتمع والعلاقات بين أفراده الالتزام بتطبيق رأي فرد أو مجموعة أفراد لمجرد تخصصهم المعرفي، أيا كان هذا التخصص. وفي هذا السياق تمحورت المداخلات حول إمكانية سن إجراءات للاعتراف بصفة "مجتهد" مع الالتزام بآثارها المتداولة في أصول الفقه. كما أثار بعض المتدخلين قضية كون اختصاص هذا المجتهد عاما في جميع مرافق المجتمع وحاجياته المتنوعة؟ أم يكون قاصرا على جزء منها؟ وكيف يتحدد اختصاص المجتهد واختصاص غيره؟
ورأت بعض المداخلات أهمية إسناد مهمة الاجتهاد أو التشريع إلى "مجمع" من العلماء أو الراسخين منهم، أو باشتراك مع متخصصين آخرين في كل دولة إسلامية أو على مستوى العالم الإسلامي… وظل الاختلاف قائما في كيفية تحقيق ذلك على ارض الواقع.
كما اقترح بعض المتدخلين إدخال تعديلات على الأنظمة المكونة لمؤسسات الدولة الحالية والمحددة لاختصاصاتها وإجراءات عملها حتى تنسجم مع أحكام الفقه الإسلامي.
3- طبيعة الحكم المقرر:
تمحور النقاش بخصوص هذه القضية حول طبيعة الحكم الاجتهادي هل هو تفسير ظني للنص؟ أم هو كشف عن حكم الله الأزلي؟ وإذا كان الرأي الاجتهادي قابلا للتعديل والتغيير فما هي الوسائل التي تضبط مراجعات الرأي الاجتهادي وتعديله أو إلغائه إن اقتضى الحال ذلك؟
وفي ختام هذه المائدة المستديرة تم اقتراح مجموعة من الأفكار لتدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الدينية في المستويات الثلاث.. ويمكن إجمال هذه المقترحات في أمرين:
أ- الجانب المؤسساتي: أهم التوصيات
- تشكيل لجنة عليا من العلماء ورجال القانون والخبراء في الميادين المختصة لدراسة كل نص يراد طرحه على الجهات التشريعية والتنظيمية لتجيزه قبل عرضه على الهيئات المذكورة، على أن يعاد إليها قبل إصداره أو تنفيذه؛ لا سيما إن كانت طرأت عليه تغييرات من إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية عند موافقتها عليه. وأن تتولى المجامع الفقهية ما يتعلق بالفتوى وخاصة في المسائل المستجدة التي لم تكن معروفة من قبل، وفي ذلك إثراء للفقه ومساعدة هامة للقضاء ومراجع الفتوى.
- تطعيم مؤسسات التقرير القائمة بالفقهاء والعلماء للقيام بدور التقنين.
ب- الجانب الإجرائي:
- البحث عن أصول للنصوص القانونية في الشريعة الإسلامية (أي تفقيه القانون)
- التكوين الفقهي للقضاة.
- المعالجة الموضوعية والمنهجية للتعارض الظاهري بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
- اعتماد التدرج والمرحلية في تصحيح القوانين ومراجعتها.
هذه بعض الأسئلة/الإشكالات المركزية التي أثارتها المائدة المستديرة وبعض المقترحات المبدئية لتدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية في الدولة الحديثة، والتي نعتقد أن فتح النقاش حولها مقدمة أساسية لبناء منظومة فقهية قادرة على الانخراط الإيجابي والمساهمة الفعالة في قضايا العالم والعصر والإنسان.
ويندرج موضوع هذه المائدة المستديرة ضمن الشواغل المعرفية التي تشتغل عليها مؤسسة دار الحديث الحسنية، وتستدعي نقاشا وحوارا حقيقيين وجادين؛ في أفق بناء تصور حول موضوع ازدواجية تقرير الأحكام المنظمة للمجتمع ولعلاقات التعايش بين أفراده، وإنهاء آثاره السلبية.
ومن المؤكد أن ما يساعد على حل هذا التعارض بين الفقه ووسائل التشريع الحديثة هو استعراض ومناقشة العناصر المعتمدة لدى الفقه ومؤسسات الدولة الحديثة في تقرير الأحكام وما بينها من اختلاف. من حيث المرجعية والجهة المختصة بالتقرير وطبيعة الحكم المقرر.
وفي هذا السياق تطرح جملة من الأسئلة المحورية، من قبيل:
*إذا كان الاختلاف واقعا في المرجعية وفي جهة الاختصاص ثم في طبيعة الحكم المقرر، فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ثابتة ومؤكدة لا سبيل إلى تجاوزها؟ أم أن الموضوع قابل للنقاش ويعد مجالا لتقديم أفكار تذيب الاختلاف؟
*هل هناك مقترحات تساعد على جعل مضامين القوانين والتشريعات محققة لمصالح المجتمع من جهة ومرتبطة بنصوص الشريعة من جهة ثانية أفضل من واقعها الحالي؛ سواء كانت هذه المقترحات تتعلق بالإجراءات العملية أو بتشكيل واختصاصات المؤسسات المسندة إليها صلاحية إصدار القوانين؟
*هل في الإمكان سن إجراءات للاعتراف بصفة "مجتهد" مع الالتزام بآثارها المتداولة في أصول الفقه وفي مقدمتها وجوب الاقتداء به من جميع الذين لم يُعتَرف لهم بهذه الصفة؟
*هل يكون اختصاص هذا المجتهد عاما في جميع مرافق المجتمع وحاجياته المختلفة؟ أم يكون قاصرا على جزء منها؟
*هل الحل كما طرحته بعض المقترحات هو إسناد مهمة الاجتهاد أو التشريع إلى "مجمع" من العلماء أو الراسخين منهم، أو باشتراك مع متخصصين آخرين في كل دولة إسلامية أو على مستوى العالم الإسلامي؛ لكن يبقى كيف يتحقق ذلك، سواء في كيفية تحديد "العلماء" أو "الراسخين" أو ذوي الاختصاصات الأخرى؟ ومن يفصل في هذا التحديد؟ وهل بعد تكوين "المجمع" تلغى السلطتان التشريعية والتنفيذية الموجودتين حاليا في الدولة الحديثة ؟ أم يوزع الاختصاص بينهما وبين المجمع؟ ومن يتولى هذا التوزيع؟ وكيف؟
تلكم جملة من الأسئلة والإشكالات التي حاولت المائدة المستديرة وضعتها أرضية للنقاش وتبادل الآراء، فاجتهد المتدخلون في مقاربتها من زوايا مختلفة من خلال محورين:
المحور الأول: الاختلاف وعناصره
1-عنصر المرجعية:
فيما يخص قضية المرجعية فإن أغلب التدخلات أشارت إلى الاختلاف بين مرجعية الفقه التي تستند إلى النصوص الدينية (القرآن والسنة) والمصلحة مع الاختلاف في تحديدها، وبين مرجعية القوانين التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات المختصة في الدولة الحديثة حسب كل ظرفية وإكراهاتها بناء على مصلحة المجتمعات ومتطلباتها.
كما أثارت بعض التدخلات الإشكالات المنهجية المتعلقة بمرجعية الأحكام الفقهية، فإذا كان مصطلح "الفقه" يشمل "فقه العبادات" و"فقه المعاملات" الذي يشمل كل المجالات التي ينظمها"القانون" بمعناه العام في الدولة الحديثة، فإن منهج البحث فيهما يبقى منهجا واحدا يختزله علم "أصول الفقه". لكن الواقع يشهد بأن الفقهين ليسا من طبيعة واحدة؛ فالعبادات أحكامها تعبدية أساسا، واستعمال "العقل الفقهي" (الاجتهاد) فيها محدود جدا ويقتصر على جزئيات تفصيلية، عكس فقه المعاملات الذي وردت فيه نصوص قطعية الثبوت (القرآن ومتواتر السنة) عامة الدلالة، ونصوص مقررة لمصلحة ظاهرة يمكن أن يتغير حكمها إذا فقدت المصلحة التي شرع من أجلها وفقا للقاعدة الأصولية "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، الأمر الذي يؤكد بأن كثيرا من أحكام الشريعة مصدرها القاعدة الشرعية "درء المفاسد وجلب المصالح"؛ سواء استندت إلى نص خاص ظني الدلالة والثبوت أو إلى نص عام. لكن الإشكال الذي يطرح في هذا المضمار هو: كيف تتحدد المصلحة أو المفسدة في التصرف أو الواقعة حتى يصاغ الحكم المناسب لها؟
وبالمقابل فإن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدرها المؤسسات المختصة في الدولة الحديثة تهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح المجتمع الذي تمثله، والأسس النظرية التي أقيمت عليها.
ومع ذلك لاحظ كثير من المتدخلين أن الاختلاف في المرجعيتين (أي مرجعية الفقه والقانون) لا يعدم قواسم مشتركة بينهما؛ سواء فيما يتعلق بالجانب المسكوت عنه في الشريعة الإسلامية (وهو ما يصطلح عليه ذوو الاختصاص بمنطقة العفو التي يحتكم فيها غالبا إلى المصلحة)، أو ما يخص الجانب الإنساني المشترك (المتمثل في العقل والفطرة والتجربة والعرف...).
1-الجهة المختصة بالتقرير:
أما مسألة الجهة المختصة بإبداء الرأي فإن أبرز الاختلافات التي أثارتها بعض التدخلات فيمكن إجمالها في ما يلي:
إن المتتبع للأدبيات الفقهية التي تناولت هذا الموضوع سيلاحظ أن ثمة جهتين للتقرير: الإمام أو الخليفة من جهة، والمجتهد من جهة ثانية. فالإمام أو الخليفة يقرر فيما أسند إليه من "تدبير المصالح العامة للأمة" وهي عبارة تشمل بعمومها كل ما يهم تنظيم مرافق المجتمع ومصالحه. في الحين الذي يقرر فيه المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي سطرها الأصوليون في الأحكام المتعلقة بالأفراد. ولكن بوقوفنا على الواقع العملي سنجد - كما لاحظ بعض المتدخلين- أن المجتهد وحده المختص بتقرير جميع الأحكام المنظمة لحياة الفرد والمجتمع؛ سواء كانت مستندة إلى تفسير نصوص خاصة أو إلى النصوص العامة ومبادئ الشريعة وكلياتها.
وتقرر في هذا المجال أيضا أن حق الاجتهاد مكفول لكل من له الأهلية لذلك، لكن الصعوبة تكمن في تعيين المنطقة الحدية التي تفصل بين "المؤهلين" لإبداء الرأي وبين عديمي الأهلية الذين يتوفرون على معرفة ولكن لا تؤهلهم للاجتهاد، كما طرحت في هذا السياق فكرة المجامع الفقهية أو المجالس العلمية كفكرة بديلة لفكرة المجتهد الفرد.
وبالنسبة للدولة الحديثة فالمؤسسات التشريعية تجري فيها الأمور على نحو مختلف يراعي مصالح المجتمع والأسس النظرية والفكرية التي يقوم عليها نظام التشريع حيث تصنف القواعد الملزمة في تنظيم المجتمع إلى دستور، وقوانين، ونصوص تنظيمية؛ فالدستور يشترك جميع أفراد المجتمع في تقريره عن طريق الاستفتاء، أما القوانين فيعهد إصدارها إلى المؤسسة التشريعية المتمثلة في البرلمان، أما السلطة التنفيذية أي الحكومة فتبقى لها صلاحية النصوص التنظيمية.
2-عنصر طبيعة الحكم المقرر:
أهم الإشكالات التي طرحت بخصوص هذا العنصر:
إن حديث الفقهاء عن الدولة كان حديثا عن الأشخاص الموكول إليهم أمر تسيير مؤسسات الدولة كالخليفة أو الإمام ولم يعالج أبدا طبيعة مؤسسة الدولة أو نظم تدبير أمورها، فهم المخاطبون بممارسة حقوق الدولة وأداء التزاماتها، والمؤسسات المعبر عنها بالولايات الشرعية تتشخص كذلك في هؤلاء الأفراد؛ أما اليوم وقد تغيرت وتطورت فلسفة المجتمع الإنساني وأفكاره إزاء مفهوم الدولة وتنظيمها، فقد برزت تخصصات قانونية ، مثل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي وغيرها من القوانين التي تسعى إلى تنظيم كافة ميادين النشاط البشري بالإضافة إلى مجموعة من النظم مثل النظام الجبائي والنظام القضائي ونظام المركزية واللامركزية، ونظام المؤسسات العمومية وغيرها من النظم التي تعنى بتنظيم الدولة ومؤسساتها.
كل هذه الموضوعات وغيرها كثير، ما تزال غائبة في الدرس الفقهي الذي لا يساهم في مناقشتها وتنويرها، ولا يقدم بديلا قابلا للتطبيق ويكتفي بنعتها بـ"القانون الوضعي" المخالف لشريعة الإسلام بما يترتب على ذلك من تداعيات .
ومن الإشكالات كذلك التي طرحت خلال مناقشة هذا العنصر طبيعة الرأي الفقهي الذي يتوصل إليه المجتهد عن طريق الاجتهاد؛ إذ أضحت الأحكام الاجتهادية مع مرور الزمن تتصف بالثبات والاستمرار مما يجعل تلك الأحكام الصادرة غير قابلة للتجديد (وهذا عكس ما أكده الأصوليون من أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ووجوب مراعاة المآل في تقرير الأحكام ….)
أما بالنسبة لمؤسسة الدولة، فإن ما تصدره من تشريعات قانونية وتنظيمية قابلة للتعديل والإلغاء، لذلك كانت القوانين سريعة التعديل والإلغاء.
وخلاصة ما ورد ضمن هذا العنصر هو ضرورة التمييز بين الأحكام الثابتة التي لا تخضع لتغير الزمان والمكان (كالأحكام المتغيرة) والأحكام التي تخضع لسنة التغيير (كالأحكام المعاملاتية). ويبدو أن مسألة الوضعية المؤقتة أو الأبدية للأحكام لم تتبلور فيها تصورات واضحة.
المحور الثاني: تدبير الاختلاف
أما المحور الثاني من المائدة المستديرة فقد حاول تقديم بعض المقترحات لتدبير هذا الاختلاف؛ بمعنى، إذا كان الاختلاف أمرا واقعا في المرجعية وفي جهة الاختصاص ثم في طبيعة الحكم المقرر، فهل هذا الاختلاف مؤسس على حقائق ثابتة ومؤكدة ستبقى دائما عائقا لتجاوزها؟ أم إن الموضوع قابل للنقاش ويعد مجالا لتقديم أفكار تقلل من مسافة الاختلاف وإن لم يتم تذويبها؟
ويمكن إجمال ما قيل حول السبل والوسائل الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات فيما يلي:
1-المرجعية :
على مستوى المرجعية لاحظ بعض المتدخلين أن درء المفاسد وجلب المصالح هو الذي يشكل المرجعية الأساسية والعليا في تفسير نصوص الشريعة واستخلاص الأحكام منها، وأن هذه القاعدة تبقى الهدف نفسه من تشريع القوانين الوضعية.
كما اقترح المتدخلون جملة من المقترحات تساعد على جعل مضامين القوانين محققة لمصالح المجتمع ومرتبطة بنصوص الشريعة أفضل من واقعها الحالي؛ سواء كانت المقترحات متعلقة بالإجراءات أو بتشكيل واختصاصات المؤسسات المسندة إليها صلاحية إصدار القوانين..
2- المصدر أو الجهة المختصة بالتقرير:
في ظل الواقع المعاصر كاد أن يحصل الاتفاق بين جميع المتدخلين أنه لم يعد مقبولا في تنظيم المجتمع والعلاقات بين أفراده الالتزام بتطبيق رأي فرد أو مجموعة أفراد لمجرد تخصصهم المعرفي، أيا كان هذا التخصص. وفي هذا السياق تمحورت المداخلات حول إمكانية سن إجراءات للاعتراف بصفة "مجتهد" مع الالتزام بآثارها المتداولة في أصول الفقه. كما أثار بعض المتدخلين قضية كون اختصاص هذا المجتهد عاما في جميع مرافق المجتمع وحاجياته المتنوعة؟ أم يكون قاصرا على جزء منها؟ وكيف يتحدد اختصاص المجتهد واختصاص غيره؟
ورأت بعض المداخلات أهمية إسناد مهمة الاجتهاد أو التشريع إلى "مجمع" من العلماء أو الراسخين منهم، أو باشتراك مع متخصصين آخرين في كل دولة إسلامية أو على مستوى العالم الإسلامي… وظل الاختلاف قائما في كيفية تحقيق ذلك على ارض الواقع.
كما اقترح بعض المتدخلين إدخال تعديلات على الأنظمة المكونة لمؤسسات الدولة الحالية والمحددة لاختصاصاتها وإجراءات عملها حتى تنسجم مع أحكام الفقه الإسلامي.
3- طبيعة الحكم المقرر:
تمحور النقاش بخصوص هذه القضية حول طبيعة الحكم الاجتهادي هل هو تفسير ظني للنص؟ أم هو كشف عن حكم الله الأزلي؟ وإذا كان الرأي الاجتهادي قابلا للتعديل والتغيير فما هي الوسائل التي تضبط مراجعات الرأي الاجتهادي وتعديله أو إلغائه إن اقتضى الحال ذلك؟
وفي ختام هذه المائدة المستديرة تم اقتراح مجموعة من الأفكار لتدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الدينية في المستويات الثلاث.. ويمكن إجمال هذه المقترحات في أمرين:
أ- الجانب المؤسساتي: أهم التوصيات
- تشكيل لجنة عليا من العلماء ورجال القانون والخبراء في الميادين المختصة لدراسة كل نص يراد طرحه على الجهات التشريعية والتنظيمية لتجيزه قبل عرضه على الهيئات المذكورة، على أن يعاد إليها قبل إصداره أو تنفيذه؛ لا سيما إن كانت طرأت عليه تغييرات من إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية عند موافقتها عليه. وأن تتولى المجامع الفقهية ما يتعلق بالفتوى وخاصة في المسائل المستجدة التي لم تكن معروفة من قبل، وفي ذلك إثراء للفقه ومساعدة هامة للقضاء ومراجع الفتوى.
- تطعيم مؤسسات التقرير القائمة بالفقهاء والعلماء للقيام بدور التقنين.
ب- الجانب الإجرائي:
- البحث عن أصول للنصوص القانونية في الشريعة الإسلامية (أي تفقيه القانون)
- التكوين الفقهي للقضاة.
- المعالجة الموضوعية والمنهجية للتعارض الظاهري بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
- اعتماد التدرج والمرحلية في تصحيح القوانين ومراجعتها.
هذه بعض الأسئلة/الإشكالات المركزية التي أثارتها المائدة المستديرة وبعض المقترحات المبدئية لتدبير الاختلاف بين الفقه والمؤسسات التشريعية في الدولة الحديثة، والتي نعتقد أن فتح النقاش حولها مقدمة أساسية لبناء منظومة فقهية قادرة على الانخراط الإيجابي والمساهمة الفعالة في قضايا العالم والعصر والإنسان.