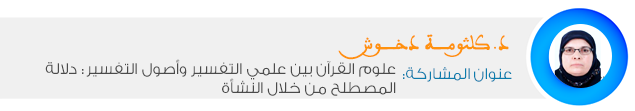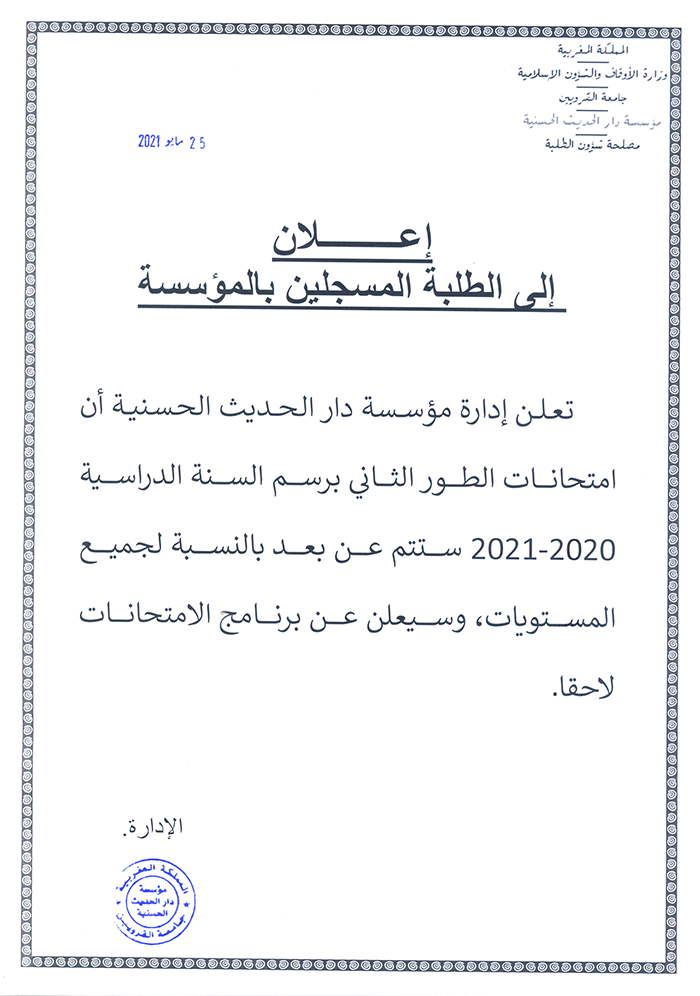بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة القرويين
مؤسسة دار الحديث الحسنية
الندوة العلمية الدولية: علوم القرآن الكريم: إشكالية المفهوم والمنهج والوظيفة
المحور: علوم القرآن إشكالية التسمية والـمُضَمَّن
التأليف في علوم القرآن: الجذور والتطور والبناء
د. أحمد كوري بن يابة السالكي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
نائب عميد كلية أصول الدين – جامعة العلوم الإسلامية بالعيون/ موريتانيا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد.
أما بعد/ فقد رأيت أن أدلي بدلوي في هذه الندوة المباركة، التي تقيمها هذه المؤسسة العلمية الجليلة، في هذا الموضوع المهم. فكان هذا البحث المتواضع، وهو بعنوان:
التأليف في علوم القرآن: الجذور والتطور والبناء
ومن أشهر تعريفات فن علوم القرآن، تعريف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني له في كتابه: "مناهل العرفان"، فقد عرفه بأنه: «مباحث تتعلق بالقرآن الكريم، من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشُّبه عنه، ونحو ذلك».
جذور التأليف في علوم القرآن:
تأخرت حركة التأليف في علوم القرآن، عن مثيلاتها في العلوم الإسلامية الأخرى، كما يقول اليوسي في قانون العلوم في حديثه عن التفسير وعلوم القرآن: «وهذا الفن لم يدونه الأقدمون - في ما رأينا - على ما تقتضيه الصنعة، وإنما اشتغلوا بتفسير القرآن العظيم بالفعل، وليس ذلك هو الفن المعدود في الفنون. وإنما ذلك بمثابة ما يقع من الحاكم من تنفيذ الأحكام، واستعمال الفروع الفقهية عند التداعي والخصام، وعند الإفتاء مثلاً، وليس ذلك هو فن الفقه ولا لازماً له ضربة لازب (..)،وقد تنبه لذلك المتأخرون؛ فذكروا معظمه كالجلال السيوطي في الإتقان، وحكى أنه سبقه إلى ذلك شيخه الكافِيَجي والجلال البُلْقِيني والبدر الزركشي».
وقد استمد فن "علوم القرآن" جذوره من فن "علوم الحديث" الذي تطور واستوى على سوقه قبل علوم القرآن؛ فتأثر به الباحثون والمؤلفون في علوم القرآن، في المصطلح والبناء. فقد كان التأليف في علوم الحديث قد بلغ أشده واستوى، في الثلث الأول من القرن السابع، أي: قبل نحو قرن ونصف من وصول علوم القرآن إلى مرحلة التصنيف الممنهج، مع البرهان للزركشي.فوجد فيه رواد التأليف في علوم القرآن تجربة ناجحة ناضجة أمامهم، حرية بالاقتداء والتأثر، في علم يمت بصلات وثيقة إلى علوم القرآن، هو علوم الحديث.على أن المؤلفين في علوم القرآن، لم ينقلوا مناهج علوم الحديث كما هي، وإنما حوروها لتتلاءم مع مُضَمَّن علوم القرآن.
ومبدأ أسبقية التأليف في علوم الحديث للتأليف في علوم القرآن، جعله المؤلفون في علوم القرآن كلمة باقية في أجيالهم، فكان حاضراً دائماً في أذهانهم. كما كان مبدأ اقتداء المصنفين في علوم القرآن بمناهج المصنفين في علوم الحديث، ظاهرة مشتركة بين المصنفين في علوم القرآن.
وليس فن "علوم القرآن" بدعاً من غيره من العلوم الإسلامية في هذه الناحية؛ فعلوم اللغة والتاريخ كلاهما أيضاً تأثر المؤلفون فيه بعلوم الحديث مصطلحاً وبناءً. وإذا كان المؤلفون في علوم بعيدة عن علوم الحديث، قد تأثروا بالمؤلفين في هذا العلم، فلا عجب أن يتأثر المؤلفون في علوم القرآن بالمؤلفين في هذا العلم، وهما علمان شقيقان.
تطور التأليف في علوم القرآن:
للباحثين خلاف طويل في أول من ألف في علوم القرآن.لكن الأقرب إلى منطق التاريخ وطبيعة الأشياء أن تطور التأليف في علوم القرآن قد مر بثلاث مراحل، لكل منها طابعها المميز، فالمرحلة الأولى تميزت بامتزاج علوم القرآن بغيرها من العلوم الشرعية، والمرحلة الثانية تميزت فيها علوم القرآن عن غيرها من العلوم الشرعية، وذلك بتخصيص المؤلفين لرسائل مفردة في مباحث خاصة من علوم القرآن، والمرحلة الثالثة تميزت باتجاه المؤلفين إلى تأليف كتب جامعة لا تختص بمبحث واحد من علوم القرآن.
وهذا التسلسل الذي سار عليه التأليف في علوم القرآن، هو التطور الطبيعي الذي يتسق مع طبيعة الأشياء، ثم هو أيضاً التسلسل الذي سار عليه التأليف في علوم أخرى، مثل علوم اللغة، وخصوصاً صناعة المعجمات.
امتازت إذن المرحلة الأولى من تطور التأليف في علوم القرآن، بامتزاج علوم القرآن بغيرها من العلوم الشرعية، وعدم تميزها عنها، وخصوصاً علم التفسير الذي هو من أكثر العلوم الشرعية لصوقاً بعلوم القرآن.
ويصح أن تسمى المرحلة الثانية: "مرحلة الرسائل المفردة"؛ لأنها تميزت بأن المؤلفين أصبحوا يفردون كتباً أو رسائل لمبحث واحد من مباحث علوم القرآن. فقد امتازت هذه المرحلة بتميز علوم القرآن عن غيرها من العلوم الشرعية، وبدأ العلماء يفردون المصنفات لمباحث خاصة من هذا العلم، فكانت هذه المرحلة تمثل برزخاً بين المرحلة السابقة والمرحلة التالية؛ فهي تختلف عن المرحلة السابقة في كون فن علوم القرآن لم يعد ممتزجاً مع علم التفسير، بل أصبح علماً قائما بذاته، تخصص المصنفات لبعض مباحثه، كما تختلف عن المرحلة التالية في أن هذه المرحلة لم يتجه المؤلفون فيها إلى تصنيف كتب موسوعية جامعة لمجموعة من مباحث هذا العلم.وقد كانت هذه المرحلة من تطور التأليف في علوم القرآن، زاداً ضروريّاً للمؤلفين في المرحلة التالية؛ فكان أساس عملهم تجميع هذه "الرسائل المفردة"، وضمها في كتاب واحد
كما امتازت المرحلة الثالثة بظهور مصنفات لا تختص بمبحث واحد من هذا العلم وإنما تدرس جميع مباحثه، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين: الأولى: مرحلة التصنيف غير الممنهج، وهي السابقة لظهور البرهان في علوم القرآن للزركشي، والثانية: مرحلة التصنيف الممنهج، وهي التي تبدأ بظهور البرهان.وفي العصر الحديث نشطت حركة التأليف في علوم القرآن، لأسباب اقتضت ذلك.
بناء كتب علوم القرآن:
بدأ تأليف الكتب الجامعة في علوم القرآن في القرن السادس كما تقدم. ويمكن تقسميه إلى ثلاث مراحل: مرحلة التأليف غير الممنهج، ومرحلة التأليف الممنهج، ومرحلة التأليف المعاصر.
واختلفت مناهج المصنفين في هذا العلم في اختيار الأنواع وتقسيمها بسبب اختلاف رؤيتهم في تقدير حجم بعض المسائل، واستحقاقها للإفراد بنوع خاصّ بها أو عدم استحقاقها لذلك. وبسبب اختلاف اجتهاداتهم في أهمية استمداد بعض الأنواع من العلوم الأخرى، وعدم استمدادها.
وعموماً فقد تميز التأليف في علوم القرآن في المرحلة الأولى (مرحلة التأليف غير الممنهج)، بابتعاده عن المباحث المستمدة من العلوم الأخرى، كعلم البلاغة وعلم الأصول. وإن كان يستمد من العلوم القريبة من علوم القرآن كعلم التفسير والتجويد والقراءات والرسم. كما تميزت مصادر هذه المرحلة بالاختصار، مقارنة بمصادر المرحلة التالية، لأن هذه المرحلة كانت مرحلة تأسيسية، ومرحلة تأليف غير ممنهج، لم يعرف هذا العلم فيها قمة تطوره بعدُ.
أما المرحلة الثانية (مرحلة التأليف الممنهج) فقد تميزت بالتوسع في المضمن وفي الاستمداد؛ لأنها مثلت قمة التطور الذي وصل إليه هذا العلم. وقد بدأ التأليف الممنهج في علوم القرآن، بالبرهان في علوم القرآن للزركشي، ثم بنى عليه السيوطي كتابه: الإتقان في علوم القرآن، ثم جاء ابن عقيلة المكي فبنى على الإتقان كتابه: الزيادة والإحسان في علوم القرآن.
وهذه الكتب الثلاثة هي أهم ما ألف في هذه المرحلة من علوم القرآن، والإتقان هو واسطة العقد بين هذه المؤلفات الثلاثة، فالبرهان أصل الإتقان، والإتقان أصل الزيادة والإحسان. وهذا التقارب بينها يقتضي دراستها مجتمعة، لاشتراكها في الخصائص الرئيسة.
وقد بلغت الأنواع عند الزركشي سبعة وأربعين، وبلغت عند السيوطي ثمانين، وبلغت عند ابن عقيلة المكي أربعة وخمسين ومائة.وعلى الرغم من التباين الظاهري بين هذه الأرقام، وإيحائها بادئ الرأي بأن السيوطي زاد نحو الضعف على الزركشي، ثم زاد ابن عقيلة نحو الضعف على السيوطي، فإن الواقع ليس كذلك، فالسيوطي لم يزد على البرهان إلا قليلاً، ولم يزد ابن عقيلة على السيوطي إلا قليلاً كذلك.
فقد جاءت هذه الكتب الثلاثة (البرهان، والإتقان، والزيادة والإحسان)، متقاربة في المضمن، وإن اختلفت في الترتيب والتنظيم. وسبب الاختلاف في مضمنها اختلاف رؤية مؤلفيها لأهمية بعض المسائل واستحقاقها للإفراد بنوع خاص بها، واختلاف درجة استمداد أصحابها من العلوم الأخرى.
وخرج عن هذه السلسلة المتجانسة كتاب: "الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة"، للرجراجي الشوشاوي. وهو كتاب مثير للعجب بسبب تميزه اللافت للانتباه. فمؤلفه مغربي، ولا تعرف للمغاربة مشاركة في تأليف الكتب الجامعة في علوم القرآن، في هذه المرحلة من تطورها.وهو مبتكر لأسلوب كتابه في ما يبدو؛ إذ لم ينص على تأثره بالمؤلفين في علوم الحديث، ولم يظهر عليه التأثر بهم، خلافاً لسائر المؤلفين في هذه المرحلة.وهو متقدم على السيوطي، ولم يذكر في كتابه اطلاعه على شيء من مصادر علوم القرآن المعروفة (كفنون الأفنان، والبرهان)، ولا من التفاسير.ويبدو أن الكتاب بقي مغموراً خارج المغرب؛ فلم يذكره السيوطي ولا ابن عقيلة بين مراجعهما، كما لم يذكر هو مرجعاً من مراجع علوم القرآن السابقة عليه؛ فكان "جزيرة" منفصلة عن تطور التأليف في علوم القرآن في المشرق.
وفي عصرنا نهض التأليف في علوم القرآن في القرن الرابع عشر، نهضة ملموسة، تمثلت في كثرة الكتب والدراسات المتمحورة حوله. ولتلك النهضة أربعة أسباب رئيسة، لم تكن موجودة في ما سلف من الزمان:
السبب الأول: تقرير مادة علوم القرآن في بعض الجامعات الإسلامية، وقد استتبع ذلك عكوف أساتذة هذه الجامعات على إعداد مذكرات دراسية لتدريس هذه المادة، وقد تحولت هذه المذكرات إلى كتب في علوم القرآن.
السبب الثاني: التصدي للرد على المستشرقين والمنصرين؛ فقد صادفت هذه المرحلة ظاهرة الاستعمار وما انجرّ عنه من ظاهرتي الاستشراق والتنصير، وقد كان البحث في علوم القرآن قبل هذا التاريخ محصوراً في علماء المسلمين، ولم يكن بينهم خلاف حول الأسس الكبرى لهذا العلم، فتميزت هذه المرحلة الجديدة بدخول المستشرقين والمنصرين على الخط، ونشرهم للكثير من الدراسات حول القرآن الكريم والسنة النبوية، تميزت بعداء واضح وتعصب مقيت، يجافي المنهج العلمي ويبتعد عن الإنصاف. فبذل علماء المسلمين جهداً كبيراً مشكوراً في الرد على افتراءات هؤلاء وشبهاتهم، وبيان انحرافهم عن المنهج العلمي.
السبب الثالث: الإجابة عن نوازل جدت في العصر الحديث، لم يجب عنها العلماء السابقون؛ لأنها لم تطرح في عصرهم، أو لم تكن بالحدة نفسها التي تطرح بها نفسها اليوم، مثل: ترجمة القرآن الكريم، والالتزام بالرسم العثماني.
السبب الرابع: ضرورة كتابة فن علوم القرآن بلغة معاصرة، تفهمها الأجيال الجديدة، التي قد يوجد فيها من لا يفهم لغة الكتب التراثية.
وبناءً على هذه الأسباب، تميزت كتب علوم القرآن في هذه المرحلة بأربع سمات مشتركة:
الأولى: الاختصار؛ فكان غالبها في مجلد واحد متوسط، أو مجلدين صغيرين، وسبب ذلك أن أصل أغلبها مذكرات دراسية، كما تقدم، فكان من الضروري أن تراعي الحجم المحدد للمذكرات الدراسية. وذلك يستوجب إلغاء بعض الموضوعات التي وردت في كتب علوم القرآن المؤلفة في المراحل السابقة، واختصار باقي الموضوعات الواردة فيها.
الثانية: التخفف من الأنواع المستمدة من العلوم الأخرى، كعلم البلاغة والأصول، فقد صار لزاماً على المؤلفين الاقتصار على المباحث الأسس لهذا العلم، بسبب الاختصار الذي اقتضته ظروف هذه المرحلة، وتحاشياً للتكرار، لكون تلك الأنواع يدرسها الطلاب في علومها الأصلية المستمدة منها، كما تقدم، وبسبب أن هذه المباحث الأسس هي التي استهدفها أعداء القرآن، أكثر من غيرها.
الثالثة: إضافة مواضيعجديدة للرد على شبهات أعداء القرآن المعاصرين، أو للإجابة عن النوازل المعاصرة.
الرابعة: الكتابة بأسلوب معاصر ولغة ميسرة.
والله الموفق للصواب.