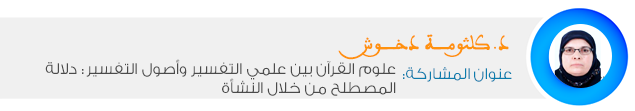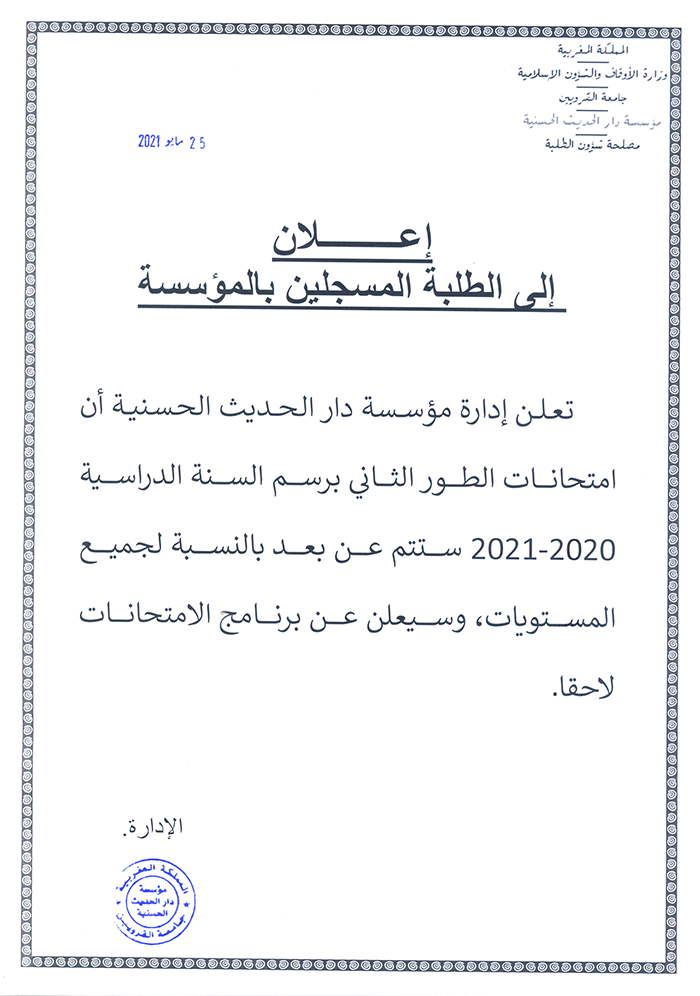بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص لعرض بحث:
الاستمداد الاصطلاحي بين علوم قراءات القرآن وعلوم الحديث: دراسة في الجوامع والفروق.
إعداد: محمد بن عبد الله البخاري
معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ـ جامعة القرويين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
تقصد هذه المشاركة إلى بيان تأثر المصنفين في علوم القرآن بمناهج المحدثين ومصطلحاتهم، خصوصا في مباحث علوم قراءات القرآن المتعلقة بالسند القرآني وطرق التحمل.
ولقد نشأت مباحث علوم القرآن التي مستندها النقل نشاءتها الأولى في أحضان الدواوين الحديثية، ثم فيما بعد جمعت مباحث علوم القرآن في مصنفات مستقلة حاذى بها أصحابها المؤلفات في علوم الحديث، وقد صرح بذلك جماعة ممن ألفوا في علوم القرآن، ولذلك قصدنا إلى دراسة الجوامع بين مفاهيم هذه المصطلحات والفوارق، من خلال تتبع المصطلحات المشتركة بين علوم قراءات القرآن وعلوم الحديث، ودراستها دراسة مقارنة تبتغي تحديد السبق الاصطلاحي والفرق المفهومي، وذلك من خلال هذا البحيث المؤسس على مبحثين اثنين: أولهما في المصطلحات المتعلقة بأسانيد القراءات. وثانيهما في المصطلحات المتعلقة بتلقي القراءات.
المبحث الأول: المصطلحات المتعلقة بأسانيد القراءات
المطلب الأول: المصطلحات المتعلقة بأنواع القراءات
ميز القراء أنواع كل من الصحيح والضعيف من المروي في القراءة، مستندين في ذلك إلى اصطلاحات المحدثين في التمييز بين درجات صحة الحديث، وقد ذكر الإمام السيوطي في الإتقان ستة أنواع من القراءات، وهي: المتواتر، المشهور، الآحاد، الشاذ، الموضوع، المدرج، وهي أنواع اقتبست مصطلحاتها من اصطلاحات المحدثين، وهذا بيانها مع التنبيه على الفوارق بين اصطلاح القراء واصطلاح المحدثين.
أولاً: المتواتر:
قال السيوطي: «هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك»().
وهو تعريف مستمد من التعريف الاصطلاحي للتواتر، ومصطلح التواتر نشأ أول ما نشأ نشأة كلامية، وفشا بعد ذلك في كلام أهل الأصول، ثم دخل إلى مدونات علم الحديث، وأقدم من ذكره وعرفه الخطيب البغدادي في الكفاية()، وذكره بعد ذلك ابن الصلاح وعده من ضمن المشهور، ونبه على مصدره الأصولي الذي منه استمده الخطيب، فقال: «ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله»().
وقد انتقل هذا المصطلح بعد ذلك إلى الأسانيد القرائية، لكن الثابت أن الأئمة المتقدمين كابن مجاهد (ت324ھ) وابن غلبون (ت386ھ) والداني (ت444ھ) وغيرهم لم يستعملوا هذا المصطلح ولا اشترطوا شروطه، وإنما استعملوا مصطلحات: القراءة المجمع عليها، والقراءة المشهورة، والقراءة المعروفة، والقراءة السائرة، وغير ذلك.
وإنما عدلوا عن مصطلح التواتر لأن شروطه لا يمكن تحقيقها في دراسة أسانيد المروي من خلاف القراء، ولا ريب أن المجمع عليه بين القراء متواتر، أما المختلف فيه بين القراء فقد وقعت فيه انفرادات كثيرة لا يمكن إثباتها على وفق حد التواتر وشروطه، فآل الأمر إلى أن المتواتر هو القرآن الذي لا خلاف في كيفية قراءاته، أما ما اختلف في كيفية قراءاته، فلا يمكن اشتراط تواتره، وأسانيد القراء إلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى النبي ﷺ هي من نقل الواحد عن الواحد، وإنما تواترت هذه الكيفيات عن الأئمة والرواة وأصحاب الطرق الذين اشتهروا بها، كما نص على ذلك الإمام أبو شامة()، وقال الإمام الزركشي: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي ﷺ ففيه نظر فإن إسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد»().
وقول السيوطي في تعريف المتواتر من القراءات: «وغالب القراءات كذلك»() يصح إن قصد به ما اتفق فيه القراء مما لا خلف فيه، وما كان من أصول الظواهر الأدائية على نحو عام، قال الإمام البلقيني: «ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة، وأنواع المد، وأنواع تخفيف الهمزة فليس من المتواتر، وأما أصل المد والإمالة فإنه متواتر، لاشتراك القراء فيه»().
ثانياً: المشهور:
قال الإمام السيوطي: «وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من الشذوذ، ويقرأ به»().
وهو تعريف مستمد من تعريف المشهور عند المحدثين، وهو في اصطلاحهم: «ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين»() ويعبر عنه بالمستفيض، وقد يطلق عندهم على ما اشتهر على الألسنة من الأحاديث التي لم تصح، وقد أضاف الإمام السيوطي في تعريفه للقراءة المشهورة شروط القراءة الصحيحة لكي لا يظن أن الضابط هو مجرد الاشتهار، وأضاف إلى ذلك السلامة من التغليط والتشذيذ، ومثل لها بما اختلفت فيه الطرق عن السبعة، ومفهومه أن ما اتفقت عليه طرق السبعة من المتواتر، وهو ما سبق بيانه قبل في نوع المتواتر، وذكر المصنفات الموضوعة في القراءات المشهورة فذكر التيسير والشاطبية والنشر وتقريبه، وكلها مؤلفات موضوعة في خلف القراءات السبع والعشر().
والتعبير بالشهرة هو استعمال القراء الأول، كطاهر ابن غلبون (ت 399ھ)، في مقدمة كتابه التذكرة في القراءات الثمان: «فإني ذاكر في هذا الكتاب ما تأدَّى إليَّ من قراءة أئمة الأمصار المشهورين...»(). وقال الإمام الداني في التيسير: «ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين»().
ثالثاً: الآحاد:
قال الإمام السيوطي: «وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به»().
والحديث الآحاد في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي لم يجمع شروط التواتر()، وهو أنواع، ومنه المشهور والعزيز والغريب، والمقصود بالآحاد في القراءات عند السيوطي غير المشهور مما صح سنده، ولم تتحقق فيه شروط القراءة الصحيحة، وهي موافقة الرسم والعربية، والاشتهار والقبول، وفي قوله «خالف العربية» إشكال، لأنه لا يمكن أن يصح سند القراءة المخالفة للعربية، فقد يصح سند القراءة التي خالفت الرسم، ويصح سند القراءة التي لم تشتهر، لكن لا يمكن أن تصح قراءة تخالف العربية، ولعل مراده أنها خالفت قياس العربية وشذت عنه، وقد مثل الإمام السيوطي لقراءة الآحاد بأمثلة فيها مخالفة للمرسوم، لكن ليس فيها مخالفة للعربية، ومن ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي ﷺ قرأ: ﴿متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان﴾().
رابعاً: الشاذ:
قال الإمام السيوطي: «وهو ما لم يصح سنده، وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة: ﴿ملك يوم الدين﴾ بصيغة الماضي ونصب ﴿يوم﴾ و﴿إياك يعبد﴾ببنائه للمفعول»().
وهو تعريف غير مسلم، لأن ما لم يصح سنده ضعيف، والشذوذ في اللغة يدل على الانفراد والمفارقة()، وهو عند المحدثين كما عرفه الإمام الشافعي بقوله: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث»().
وبهذا المعنى استعمل عند القراء، وهو ما انفرد به قارئ عن إجماع القراء، قال الإمام نافع: فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته، وما شذ فيه واحد فتركته»().
فتحصل أن الشاذ هو ما صح سنده وتفرد به قارئ من القراء الذين لم يجمع على الأخذ بقراءتهم، وهو قريب من نوع الآحاد السابق، أما ما لم يصح سنده فهو الضعيف والمردود. ولم يذكره السيوطي.
خامساً: الموضوع
ولا يخفـى، وهو المكذوب المختلق المصنوع، ومثل له السيوطي بقراءات الخزاعي()، وهو من أئمة القراءات، ولم يكن موثقا في نقله كما قال عنه الذهبي()، ونقل الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي العلاء الواسطي أن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف ونسبه إلى أبي حنيفة، واشتهر هذا القول ونقل عنه، لكن الإمام ابن الجزري برأه منه، وقال: «لم تكن عهدة الكتاب عليه، بل على الحسن بن زياد، وإلا فالخزاعي إمام جليل من أئمة القراء الموثوق بهم»().
أما مثال الوضع في القراءة فيمكن أن نمثل له بما روى الخطيب البغدادي في تاريخه: «عن أبي الحسن الدارقطني. قال: محمد بن يوسف ابن يعقوب الرازي، شيخ دجال كذاب، يضع الحديث، والقراءات والنسخ، وضع نحوا من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل.. قدم إلى هـهنا (أي: بغداد) قبل الثلاثمائة فسمع منه ابن مجاهد وغيره، ثم تبين كذبه فلم يحك عنه ابن مجاهد حرفا»().
سادساً: المدرج:
قال الإمام السيوطي: «وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث: المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص: ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾ أخرجها سعيد بن منصور. وقراءة ابن عباس: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج﴾. أخرجها البخاري»().
والإدراج عند المحدثين نظير الإدراج في القراءة، وهو: «أن يدرج الراوي في حديث النبي ﷺ شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه ﷺ»().
وهذا القراءات المدرجة إنما سميت قراءة تجوزاً، وقد تساهلوا في أمر إدراجها لأن علمهم بالقرآن يعصمهم عن أن يلتبس عليهم بما أدرج على سبيل التفسير.
فهذه ستة أنواع من القراءات ميزها السيوطي ورتبها على نسق أنواع الحديث، وهو المتواتر، والمشهور، والآحاد، والشاذ، والموضوع، والمدرج.
وعند التأمل في الأنواع السابقة نجد أن التواتر يختص بما لا خلاف فيه بين القراء من كيفيات أداء القرآن، وما لا خلاف فيه غير داخل في علم القراءات، ونجد أن الآحاد والشاذ بمعنى واحد، فآلت أنواع القراءات إلى:
• المشهور: وهو ما أجمعت عليه الأمة من خُلف القراءات السبع والعشر.
• الآحاد أو الشاذ، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو انفرد به قارئ لم يكتب لقراءته الاشتهار.
• الموضوع: وهو المختلق المصنوع.
• المدرج: وهو ما أدرج على سبيل التفسير.
والأولان ثابتان صحيحان، والآخران على عكس ذلك، ولذلك استقرت القسمة بين القراء على نوعين: قراءة مجمع عليها وقراءة شاذة.
المطلب الثاني: المصطلحات المتعلقة بالعالي والنازل من أسانيد القراءات.
اقتبس الإمام السيوطي(ت909ھ) في الإتقان مصطلحات العلو والنزول في الإسناد عند المحدثين كما أوردها الحافظ أبو الفضل ابن القيسراني (ت507ھ) في كتابه: «مسألة العلو والنزول في الحديث»() وتبعه ابن الصلاح(ت643ھ) في مقدمته، وقاس عليها أسانيد المقرئين، وهذا بيانها كما أثبتها الإمام السيوطي:
الأول: القرب من رسول الله ﷺ().
القرب إلى إمام من الأئمة السبعة ().
العلو بالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة في القراءات كالتيسير والشاطبية، ويقع في هذا النوع: الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحات().
ثم فصل في بيان ما يقع في النوع من الموافقات والإبدال والمساواة والمصافحات متابعاً في ذلك ابن الصلاح.
تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه... »().
العلو بموت الشيخ، لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر متى يكون...
ثم قال بعد التمثيل لكل نوع منها: «فهذا ما حررته من قواعد الحديث وخرجت عليه قواعد القراءات، ولم أسبق إليه ولله الحمد والمنة»().
المبحث الثاني: المصطلحات المتعلقة بتلقي القراءات
المطلب الأول: المصطلحات المتعلقة بطرق نقل القراءة وتحملها.
ذكر الإمام السيوطي ـ في كتابه الإتقان في النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله ـ أوجه التحمل عند المحدثين وعارضها بأوجه تحمل المقرئين، فقال: «وأوجه التحمل عند أهل الحديث: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسماع عليه بقراءة غيره، والمناولة، والإجازة، والمكاتبة، والوصية، والإعلام، والوجادة، فأما غير الأولين فلا يأتي هنا لما يعلم مما سنذكره»().
وقد اقتصر منها على وجهين رأى إمكان تحمل القراءن بهما، وهما: العرض، والسماع، وإنما اقتصر عليها لأن العمل في تلقي القراءة جرى في العصور المتأخرة على الاقتصار عليها، لكن من طالع نصوص الأولين وجدهم يعتمدون في التلقي على التحديث والإخبار، وعلى المناولة والإجازة والمكاتبة والوجادة.
فأما التحديث أو الإخبار، فهو مقابل للرواية والعرض عند القراء، ولم يذكره السيوطي رغم أن اعتماد القراء عليه ظاهر، والتحديث أو الإخبار خاص بسماع حروف الخلاف أو عرضها دون حروف الاتفاق، وقد جرت عادة المصنفين في القراءات على التمييز بين أسانيد القراءة، وأسانيد التحديث أو الإخبار.
ومن أشهر من تلقى الحروف رواية دون القراءة: الإمام حمزة بن حبيب الزيات عن الأعمش، ومذهب المتقدمين التسوية بين العرض ورواية الحروف، قال الإمام الداني رحمه الله معقباً على تلقي حمزة عن الأعمش: «ليست الفائدة في نقل الحروف ذوات الاتفاق، وإنما الفائدة في نقل الحروف ذوات الاختلاف، فإذا كان حمزة قد سأل الأعمش عن قراءته المختلف فيها حرفاً حرفاً، وأجابه الأعمش بمذهبه الذي نقله عن أئمته، فذلك وقراءة القرءان كله سواء في معرفة مذهبه»().
وأما المناولة فهي أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، ويجيز له الرواية عنه.
وأما الوجادة فهي أخذ حروف القراءة من الكتاب، ولا يعول عليها، لأن القرآن لا يتلقى من المصاحف ولا الكتب، ولا بد فيه من مشافهة وملاسنة.
ويلحق بالمناولة والوجادة: الإجازة، وهي عند المحدثين إجازة مجردة عن السماع والعرض، وعند القراء لا اعتبار بها إلا على سبيل المتابعة لمن جمع القراءات وضبطها.
المطلب الثاني: المصطلحات المتعلقة بتعديل القراء وتجريحهم
قال الإمام أبو شامة واصفاً حال القرأة قبل تسبيع ابن مجاهد: «فمنهم المحكم للتلاوة، المعروف بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بسبب ذلك الاختلاف، وقل الضبط واتسع الخرق، والتبس الباطل بالحق، فميّز جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم، وحرروه وضبطوه في تآليفهم، وقد أتقن تقسيم ذلك الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد رحمه الله تعالى في أول كتاب السبعة له»().
والتقسيم المتقن الذي أحال عليه أبو شامة هو تقسيم ابن مجاهد في مقدمة كتاب السبعة لمراتب القراء الأربع، وهي:
1. منزلة الإمام العالم بالوجوه واللغات والمعاني، المنتقد للآثار، الذي عليه المعتمد وإليه المفزع.
2. ومنزلة القارئ المطبوع الذي يقرأ على سجيته السليمة.
3. ومنزلة الحافظ بلا دراية ولا علم، ولا يلبث أن ينسى.
4. ثم منزلة القارئ المبتدع الذي لا يلتزم بالإسناد ويخالف الإجماع.
وهذه الألقاب الأربعة سبق إليها ابن مجاهد وميز بها بين منازل قرأة القرآن، ورغم أهميتها فإن المصنفين في علوم القرآن لم يعتنوا بها، والفروق بينها وبين اصطلاح المحدثين كالآتي:
الحافظ عند المحدثين من ألقاب التعديل وعند القراء أيضاً في الاصطلاح العام، لكن في اصطلاح ابن مجاهد الخاص هو الحافظ الذي لا دراية له، وهو عنده غير معتمد في النقل، ولا ينبغي الأخذ عنه.
والمبتدع؛ وعند المحدثين تفصيل في عدالته وجواز الأخذ عنه تبعاً لأثر بدعته وصلتها بمرويه، لكنه عند المقرئين مبتدع في القراءة وضّاع كذاب مجروح لا يجوز الأخذ عنه.
وختاماً: فهذه كلمات حاولت الإبانة عن أمر الاستمداد الاصطلاحي بين علوم قراءات القرآن وعلوم الحديث، وقد أظهر البحث أنها لم تكن تبتعد في مفاهيمها عن دلالاتها في علوم المحدثين، كما توقف البحث عند بعض المصطلحات التي أغفلها المصنفون في علوم القرآن، واعتمدها القراء في مصنفاتهم، كمصطلح التحديث والإخبار بحروف القراءة، ومصطلحات مراتب القراء ودرجاتهم، وهي: الإمام، المطبوع، الحافظ، المبتدع.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.