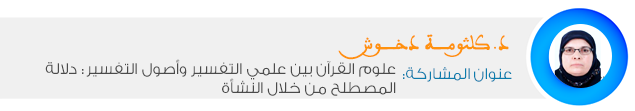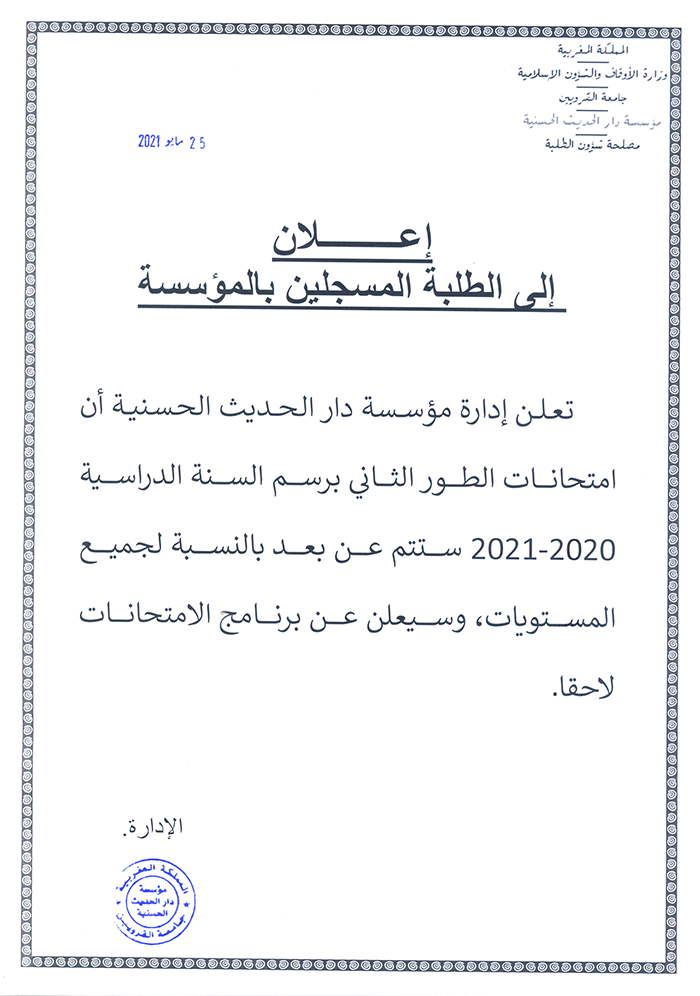ملخص نسق علوم القرآن: إشكالية المخرجات وصياغة الآليات
الدكتور رضوان رشدي، رئيس مركز ابن رشد للدراسات والأبحاث الإنسانية
أولا: ضبط النسق ماهية ومخرجات
إذا كان مدار صلاح الناس على الوحي الإلهي الذي هو متساوق مع العالم الكوني في تجلية الحكمة الإلهية المفضية إلى إسعاد البشرية، فإن الهمم تقتضي الارتكاز على العلوم التي توضح حقائقه وتدقق في ماهيته وتعين على فهمه وإدراك معانيه، ولم تكن المنارات المضيئة للنص القرآني في وقت مضى سوى علوم تجشم العلماء مشاقا في إبرازها إلى الوجود لتعين الباحث على استيعاب متعلقات النص القرآني تنزلا وكتابة وزمانا ومكانا وسببا وتفسيرا ... لكنه عند تأمل يسير في المنهج المعرفي المتبع في تلك العلوم، يلفاها معتمدة على التاريخ و النقل والاسترجاع والاستيثاق فضلا عن محدودية النسق ... وكأنها أسس ثابتة قائمة بذاتها بحيث يتمكن اللبيب المستوعب لمصادرها من ضبط كلياتها واستقراء جزئياتها، لاسيما وإن تكرار النسق المعرفي بفنونه المختلفة هو مجسد بذاته في جل مصنفاته التي تنحو نحو التسليم للمعرفة وإرسالها باستصحاب أقوال المتخصصين لها قبلا.
والإشكال المطروح هاهنا هو: هل يمكن للناظر الموضوعي الذي مارس الوعي العميق لتلك العلوم أي يستكمل آليات الفهم الدقيق للنص القرآني لاسيما وإن عدته العلمية إنما هي استقراء حثيث وتتبع دقيق لكليات علوم القرآن فضلا عن شواردها؟ وكأن التدقيق في مخرجات نسق علوم القرآن تبدو ضرورية هاهنا، وإلا فهو العبث عينه حينما يمضي الباحث زمنا متطاولا في تتبع علوم عديدة متعلقة بالقرآن ثم يجد ذاته خلوا من التمرس المطلوب في فهم النص القرآني فهما عميقا فضلا عن استنباطه للحكم تساوقا مع الفقهاء في ديدن الاستنباط.
ثم إنه بفعل تراكمي لعلوم خاصة بالقرآن، أفضى تسطيرها في الكتب على أنها العلوم المخصوصة بالقرآن فهما وتفسيرا واستنباطا لمعانيه، لكنه بتأمل يسير لما دأبت عليه تلك الكتب الحاوية لعلوم القرآن، نلفي استجماعا لمباحث تخص القرآن نفسه بسرد بعض من خصائصه روائيا دون اعتبار للآليات المنهجية المعينة على الفهم الكلي له.مما يقتضي طرح أسئلة إشكالية:
لم غلب المنهج التاريخي في سوق المباحث القرآنية على مسار التقعيد للآليات المنهجية ؟
ألا يعتبر المنهج التاريخي الروائي عائقا في وجه النفاذ إلى استجلاء الفهم الكلي للقرآن؟
ألم تخضع تلك المباحث للصيرورة الزمنية التي عاشها العقل الإسلامي قديما؟
ثانيا: من التاريخ إلى المنهج
إنه حين نحتنا عميقا لجل المصنفات التي اعتمدناها في بحثنا، وجدنا سطوة منهج تاريخي وقوة لثقله في المباحث القرآنية، بل إن بعضا من الباحثين قد وسموا تلك العلوم القرآنية بأنها الوجه التاريخي للقرآن كذات فحسب، وكأنها علوم تاريخية للنص القرآني، مما يستلزم طرح إشكالية منهج التعامل معها واستنباط آليات منهجية معينة على التدبر الكلي للقرآن، وهو الديدن الذي سرحنا فيه وتشجمنا صعابا فيه باتخاذ السبل الآتية، لاسيما وجل المباحث القرآنية كانت نسبية احتوشتها الروايات التاريخية البعيدة عن الآليات المنهجية للفهم والتدبر.
1. التدقيق في مصطلح العلم: وأردنا به غلبة الجانب المنهجي على السوق التاريخي مع حضور العلية التي تبين المقاصد من الشيء المراد بحثه نفيا للعبث، وقد يستولي عليه التجريد غالبا، بخلاف التدقيق في جزئيات لا ناظم لها.
2. التوجه رأسا نحو المباحث التي تضم في عمقها منهجا علميا نستصحبه في أصل التدبر. وذلك بالبحث في إمكانية استجماع البحوث التاريخية المبثوثة في طيات علوم القرآن ثم صياغتها في قوالب عقلية لتغدو آليات مساعدة لفهم النص القرآني جملة دون انزياح نحو الفعل الفقهي المرتبط بمجال الاستنباط، وكأننا عقدنا العزم على استخلاص آليات وقواعد عقلية من زبد علوم القرآن تفيد في استيعاب الفهم الكلي للنص القرآني عوض السبح في فضاءات النصوص النقلية التاريخية المتعلقة بزمن النص ومكانه وغير ذلك مما هو مبثوث في عمق تلك العلوم.
من تلكم الآليات المنهجية:
1. إعتبار المكي زمنا حفظت فيه الأصول الكلية التي ساهمت في تغيير الفرد والمجتمع والحضارة ولم تقتصر على الحد الأدنى من الفعل المنبسط على الناس كلهم، وكأن الارتقاء إلى المستويات العليا هو المجال الحقيقي في بروزها، لاسيما وإن الصحابة في هذا العهد لم يلتزموا بالمستوى الأدنى الذي سيعرف فيما بعد بالحكم الشرعي الذي يرفع به الحرج. وعند تصفح الموافقات، نجد الإمام الشاطبي قد أرجع هذا الأصل إلى ما جرى عليه السلف من الصحابة في التنزيل المكي قبل تحديد الأحكام وضبطها شرعا في التنزيل المدني، إذ هؤلاء الأوائل إنما أخذوا بالأصول الكلية التي حفظت في التنزيل المكي فضلا عن غيرها من الضوابط التشريعية المدنية، آخذين بعين الاعتبار أن فترة تأسيس الإنسان قيميا إنما هي فترة العهد المكي الذي ساهم التنزيل فيه بتغيير الفرد والأمة، وإن كان عدد الصحابة قليلا، لكن ما تشربوه من مشكاة التنزيل المكي من أصول كلية كان سببا لإحداث أغرب تحول بشري همة وإرادة وتغييرا حضاريا.
ومن ثم فالأصول المكية التأسيسية البنائية للإنسان والواقع الوضيء لم تنسخ ولم تطلها يد الإبطال.
وما أهمنا حقيقة هاهنا هو أن الآلية المنهجية المعينة للفهم العميق للنص القرآني تقتضي التفريق بين الأصول الكلية التي حفظت في العهد المكي وجعلها مقدمة على الفروع الجزئية التي كانت في الزمن المدني، لاسيما وإن هناك تراتبية بين الأصول والفروع والكليات والجزئيات.
2. إعتبار سبب النزول مدخلا لدراسة الواقع البشري وسنن الاجتماع الإنساني، ذلك أنه حين يستحضر المتدبر للقرآن الواقع البشري وما يتموج فيه من متغيرات فضلا عن إدراك قوي للسنن الاجتماعية المؤثرة على الاجتماع الإنساني، فإنه سيفهم سير التاريخ الذي صنعه الأنبياء وكذا علل الحضارات.
ثم إن سير النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره النموذج الواقعي المجسد للقيم القرآنية يدفعنا لاستصحاب الواقع النبوي في تنزل الآي، ومن ثم الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية مسألة هامة في عملية التدبر.
وفي ديدن الأحكام الجزئية المستنبطة من القرآن يبدو الإطلاع على فهم أحوال الناس ومعاشهم وجزئيات واقعهم مسألة ضرورية في فقه التسديد الجامع بين التجريد والتجسيد، لذلك أعطى العلماء الواقع منزلة كبرى في فقه التنزيل لتوضع تصرفات الناس كلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سياج الفهم الكلي القرآني لاسيما في هذا الواقع المعاصر المتشعب الذي يقتضي إدراكا عميقا لأصول علم الاجتماع والنفس والتربية والاقتصاد والتاريخ والسياسة والقوانين الدولية…ونحوها من الدراسات الإنسانية الكاشفة عن وقائع الناس وأحوالهم وأعرافهم.
ثم إن درايتنا بأسباب النزول وتتبعنا لمساراتها الجزئية ستهب للمتدبر تقطيعا زمنيا به تتضح رؤية التغيير الكلي للواقع النبوي الذي اتخذت فيه قضية التغيير منحى تدرجيا تساوقا مع التحديات الواقعية.
3. نفي التجزيء واعتماد وحـــــــــــدة النظــــــــــــم والسيـــــــــــاق: وهي من الآليات اللغوية المبثوثة في مصنفات علوم القرآن ووسيلة أساسية لإدراك المراد من الآي وتفهم ألفاظها، لاسيما وإن النصوص هي مختلفة الأوضاع والأساليب، وهي من حيث الغموض والخفاء على غير وزان واحد، ومن ثم فالكلم في القرآن له سلك ينظمه، وجامع يجمع شمله ويؤلفه ويجعل بعضه متناسقا مع الآخر في اتساق وترابط وثيق، بل إن من صور إعجاز النص القرآني تساوق اللفظ مع لفظ آخر ليخرج المعنى القرآني إلى الوجود. خلافا للذين قبعوا في اللفظ واعتصاره دون الغوص إلى معناه أوإدراك فحواه، لاسيما وإن اللفظ لا يُبتغى لذاته إنما للمعنى الحامل له، ومن ثم، فالبحث عن دلالة اللفظ قصد مراعى عند الألباء.
وفي ديدن الفهم العميق للنص القرآني يبدو لنا أن دلالة السياق حاضرة بقوة حين يطرأ إشكال في الفهم المقصود من النصوص، لاسيما تلك التي تنبئ في ظاهرها عن معارضة للمقاصد الشرعية التي عضدتها نصوص شرعية عدة.
وهكذا فاستجماع النسق القرآني واستخرج محور السورة بأكملها، أمر لا يتوصل إليه من لم يستف السورة كلها بالنظر، ولم يوسع أفق التدبر والإطلال على المعاني كلها.
4. ضبط ما يتوهم من المختلف تعارضا وصفات.
في التعارض الظاهري: أوضحنا أن الذي يريد أن يتوثب لكي يعمق النظر الكلي في القرآن، فإنه بداهة سينظر إليه أنه وحدة متجانسة يعضد بعضه بعضا وإن بدا له بعض التعارض ظاهريا، ومن ثم فجعل القرآن أشطرا متباعدة لكي يلج المفسر إلى النسخ باعتباره حلا للتعارض الظاهري هو سلخ لمعاني القرآن الكلية وإبقاء على التي ظنها راجحة في عرفه. وحيث إن الفهوم البشرية نسبية فإن البقاء الأول والأخير للنص الحامل لمعانيه، ومن ثم فالتوجه إلى القرآن في نظرنا هو توجه إلى آياته كلها بمعانيها كلها دون استثناء بحيث إنه لن تتزحزح مبانيه ومعانيه عن الوجود الفعلي وامتداد معانيه في حياة الناس.
وكلما دقق النظر المتدبر في جملة الآي وسياقاتها ودلالاتها اللغوية ألفى بأن تعارض الآيات الجزئية الذي طرحوه إنما هو وهم في الحقيقة لاسيما حين نجد أن المحرك لذاك التعارض إنما هي ذهنية ظاهرية قصرت عن الغوص في الدلالات الكلية للسياقات القرآنية ولم تدرك أن التعارض هو غير مستساغ من الناحية الوجودية، وذلك أن العقل القاصر في الاستيعاب الكلي لدلالات الآي لن ينبري حقيقة لينصب نفسه حكما بين الآيات المتعارض في عرفه مع العلم أن الحكمة الإلهية السارية في الكون لا تقبل التناقض ليسري في المعادل الموضوعي له وهو القرآن ...
وفي المتوهم صفات: بينا أن ما يعتقده الناظر العجل للقرآن من أن هناك آيات متشابهة واردة في الصفات الإلهية ليتجاسر على قياسها على الشاهد مع الفروق الحاصلة بينه وبين الغائب هو محض وهم، والسبب في نظري أن ذاك الجدل إنما هو ضارب في الزمن السحيق حين برزت مسألة القول بخلق القرآن إلى الوجود. وقد حقق علماء في هذه المسألة بأن فرقوا بين فعل القارئ للقرآن، والقرآن ذاته، بحيث إن أفعالنا مخلوقة كما صرح البخاري، والقرآن إنما هو كلام الله تعالى، منه خرج وإليه يعود، لكن الذي طرأ فعلا أن هناك من ادعى مناصرة الإمام أحمد بحمل الصفات الإلهية محمل الحس، فسقط في تشبيه الذات الإلهية بغيرها من الذوات الفانية مدعين الاستواء جلوسا، وكلام الذات الإلهية تلفظا بصوت وأضراس ولهوات، فكان بذلك انفتاح الباب على مصراعيه لعلة عقدية مازالت ممتدة إلى الآن وهي علة التشبيه والتجسيم، وما سؤال الأينية الذي يطرحوه دوما من أجل تثبيت عقيدتهم لهو خير مثال على ذلك. وما قول ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه عنا ببعيد، ليتبين للناظر الحصيف المرتكز العقدي العميق الذي يستند عليه المغاربة من أصول أشعرية متناغمة مع الوارد في القرآن من الصفات الإلهية وتأويلها على النسق اللغوي خلافا للفهم الظاهري الذي أخرج أنساقا عقدية تكفيرية يعج بها الواقع الإنساني.