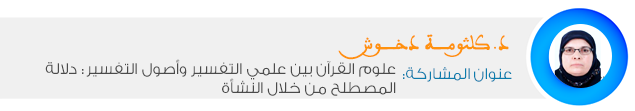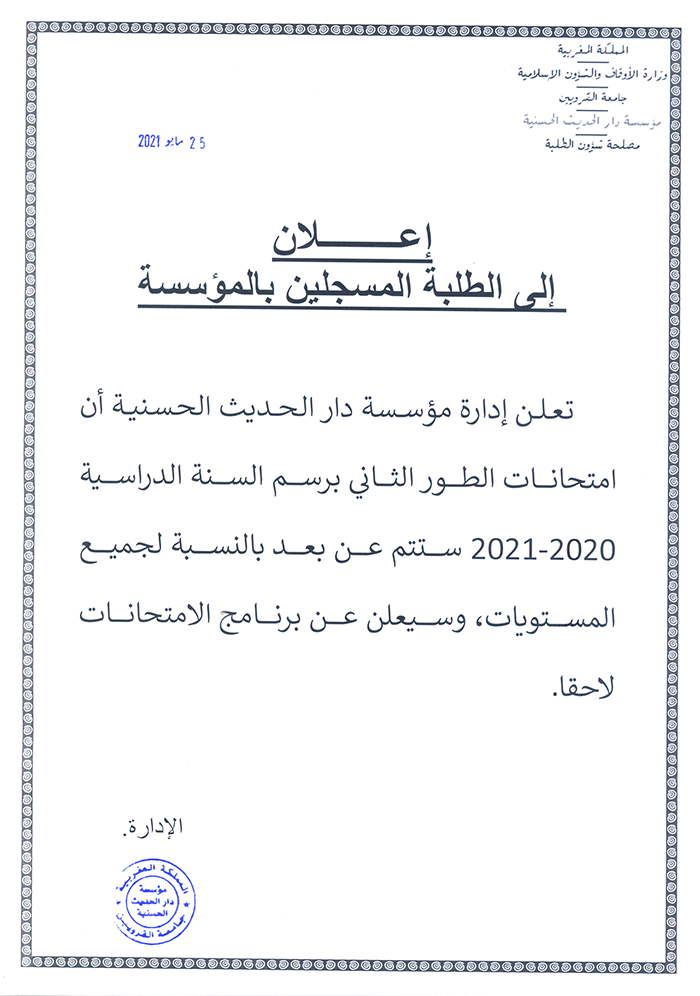د: عدنان أجانة.
تأتلف علوم القرآن من مؤلفات معرفية، ذات اختلاف في أغراضها وتباين في موضوعاتها وتنوع في مناهجها. تنسجم فيما بينها على جهة من التناسب يؤكد خاصية التكامل الوظيفي والتداخل المنهجي بين العلوم الإسلامية ويكشف عن مدى تلاحمها وارتباطها في مقاصدها وأغراضها.
والناظر في عمل المؤلفين في علوم القرآن يلحظ ما فيه من إبداع كبير وجهد ضخم في استدعاء جمل من العلوم التي يحتاجها المفسر، ثم تأليفها وتركيبها في صورة علم جامع يخول للمفسر استثمارها وتوظيفها ويؤسس لرؤية منهجية واضحة في التعامل مع الخطاب القرآني.
ولا يخفى أن مشروعا بهذا الحجم يتطلب قدرا كبيرا من العمل المنظم، وأساسا منهجيا يتم على وفقه الترتيب والتنظيم والاستثمار، وقبل ذلك تصورا واعيا لطبيعة هذه العلوم ومستويات تداخلها. وتصورا لطبيعة الخطاب القرآني وخصوصيته التداولية.
والملاحظ أن المؤلفين في علوم القرآن وهم في غمرة هذا المشروع الضخم، ركزوا على استدعاء هذه العلوم وجمعها وتركيبها على وجه غلب عليه الإحصاء والتحصيل والتعداد والتفصيل، ولم يعنوا من الناحية النظرية ببيان الأصول المنهجية والقواعد التي تنبغي مراعاتها عند إعمال هذه العلوم مجتمعة عنايتهم بإحصائها وتعدادها.
ومن أثر ذلك ما يجده الناظر في موقع علوم العربية من علوم القرآن، وهو من أبين المواضع التي تحتاج إلى تحقيق النظر في صفة التكامل والتداخل، وذلك لمركزيتها ضمن علوم القرآن وأهميتها في تشكيل قسم كبير منها. بل علوم العربية في نشأتها مدينة للقرآن الكريم موضوعا ومنهجا ومقصدا، وفي فلكه تأصلت الدراسات العربية على اختلاف أنماطها.
وينبغي التفريق عند النظر في موقع علوم العربية من علوم القرآن بين جهتين:
الأولى: جهة العلاقة بين علوم العربية بغيرها من علوم القرآن، ولنسمها العلاقة الخارجية.
الثاني: جهة العلاقة بين علوم العربية من نحو صرف وبلاغة ومعجم ونحو ذلك بعضها ببعض ولنسمها العلاقة الداخلية.
وهاتان الجهتان تبرزان مستوى التداخل المنهجي بين مؤلفات علوم القرآن. ويسهل من خلالها الفحص عن مقتضيات التداخل وشروطه.
فأما المستوى الأول، فإن الأبواب التي يتنظمها الدرس اللغوي في مؤلفات علوم القرآن نسبتها نحو الثلث من باقي العلوم. وهي نسبة كبيرة لها قيمتها في البناء النظري لعلوم القرآن الكريم.
وهذه النسبة مبنية على مركزية الدرس اللغوي في علوم القرآن وتوقفها عليه، وهو أمر يقرره كل من ألف في علوم القرآن والتفسير.
والناظر في وجه ترتيب أبواب علوم القرآن يجد فيها غياب النظرة الكلية الجامعة، فقد جرى تعددا هذه العلوم من غير استحضار علاقتها التي تجمعها بغيرها، وإذا كان يسهل على الناظر في هذه العلوم معرفة مسائلها المفردة فإنه يصعب عليه أن يضع هذه العلوم في مكانها النظري الملائم لها.
وهذا الفصل بين الأنواع المنتمية إلى علوم اللغة وتفريعها أدى إلى تجزيئها على مستوى الذكر والترتيب، ولم يجمع المؤلفون في علوم القرآن هذه المباحث اللغوية تحت عنوان واحد كبير، يسمونه علوم العربية أو نحوها، وهو أمر كان يقتضيه الاقتصاد في التنظير، وإعطاء مداخل محدودة للتفسير.
وقد أسهم عدم ضبط الإطار النظري في استثمار الدرس اللغوي وعدم جمع المباحث المنتمية إلى علم واحد في باب واحد وعدم ترتيب الأبواب ترتيبا نسقيا منهجيا في تفاوت التوظيف بين العلوم اللغوية.
ويظهر ذلك في صنيع المفسرين الذين كان يغلب عليهم الفن الذي يتخصصون فيه على غيره من العلوم، فتباينت مستويات حضور هذه العلوم في مدونات التفسير وحصل التفاوت بينهم من مكثر من علوم العربية ومن مقل ومن مقتصر على علم دون آخر نظرا لعدم استحضار جهة العلاقة الضابطة لموقع علوم العربية من علوم القرآن.
وقد كانت ثمة اقتراحات منهجية لتجاوز التفاوت في استثمار هذه العلوم، وضبط جهة موقعها من علوم القرآن، وقد تطور هذا النظر واستغنى على يد أبي حيان الغرناطي في كتابه البحر المحيط بما يمكن عده أنموذجا ضابطا ومنهجا إجرائيا يعين على ضبط موقع علوم العربية من علوم القرآن، وقد ذكر في مقدمة الكتاب منهجه في التفسير، وقرر فيه مسائل ترجع إلى ضبط علاقة الدرس العربي بالتفسير معتمدا على ثلاثة مسالك منهجية.
أما المسلك الأول، فهو تقسيم الخطاب القرآني إلى مستوى المفردة ومستوى التركيب. وفي هذا التقسيم حصر لجهات النظر وبيان لموضوعات المسائل، وتنصيص على ما يستدعيه كل موضوع من المعرفة المعرفة به الكاشفة عنه.
ففي مستوى المفردة يحضر علم اللغة والصرف، الأول ينظر في معاني المفردات والثاني في بنية المفردات.
وفي مستوى التركيب يحضر علم النحو والبلاغة. الأول ينظر في وجه التعلق بين المفردات والثاني في مقتضيات التركيب وعلاقتها بالمقام.
وهو بهذا التقسيم الإجرائي يفرز بين مستويات الخطاب القرآني وما يناسب كل مستوى.
وأما المسلك الثاني؛ فهو يقوم على تسمية العلوم بدل المسائل، فسمى علم اللغة وعلم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة. وهو بهذه التسمية يفتح المجال أمام المفسر ليمتح من مسائل هذه العلوم من غير تقييد بمسألة بعينها، بل يترك الأمر لاختيار المفسر، فليست المسائل التي ذكرت في كتب علوم القرآن هي كل المسائل التي يستفاد منها من هذه العلوم. بل ثمة مجال لتوسيع الاستفادة من أبواب ومسائل أخرى ذكرت في هذه العلوم.
وأما المسلك الثالث، فيقوم على استثمار علوم العربية بالتداخل مع غيرها من غير فصل لها. فهو لا يفصل الدرس اللغوي عن غيره بل يدمجه فيه مكونا بذلك منهجا واحدا متعدد الأدوات متوحد الأغراض.
ففي باب المفردة مثلا يعتمد علم اللغة وعلم الصرف ويدخل فيه مباحث علم القراءات والسياق الدال على موقع كل كلمة في التركيب.
وفي باب التركيب يدمج علم النحو والبلاغة مع غيرهما من مباحث الفقه والأصول وما تقتضيه الآية من بيان.
وهو بهذا المسلك يجعل علوم العربية متداخلة أشد التداخل مع غيرها بحيث لا يمكن الفصل بينها إلا على مستوى النظر والإجراء.
ثم يقرر بعد ذلك أصولا عامة وقواعد منهجية كبرى تشرف على إعمال هذه العلوم. يمكن صياغتها على الوجه التالي:
الأصل الأول: يستحضر من علوم اللغة في التفسير ما يحتاج إليه الخطاب ويتوقف عليه.
الأصل الثاني: تحتفظ هذه العلوم برتبتها داخل نسق علوم القرآن من خلال توظيفها المناسب في الجهة التي يحتاج إليها فيها.
الأصل الثالث: التبحر في علوم اللسان شرط في توظيف هذه العلوم في التفسير.
الأصل الرابع: تقرير المسائل اللغوية والاحتجاج لها يؤخذ من كتب أهلها المتخصصين فيها.
الأصل الخامس: ينبغي تجنب المسائل الضعيفة في العربية. والتي لم يقل بها أحد من الأئمة المعتبرين الذين يؤخذ بقولهم في العربية.
الأصل السادس: عدم التعرض لذكر مسائل أجنبية عن التفسير كالخلافات النحوية والاحتجاج لها والتعليل ونحو ذلك مما يذكر في الأصول.
ومن خلال هذا التصور الذي اقترحه أبو حيان يتخذ الدرس اللغوي موقعه من علوم القرآن، وتنضبط به منزلته، استمدادا واستثمارا.
وبهذا الصنيع يكون أبو حيان قد أقام تصورا واضحا المعالم لمستويات التداخل المنهجي بين علوم القرآن والدرس اللغوي، وحقق بذلك علاقة علوم العربية بعلوم القرآن.
وأما المستوى الثاني من النظر، وهو جهة العلاقة بين علوم العربية من نحو صرف وبلاغة ومعجم ونحو ذلك بعضها ببعض.
والنظر هنا أخص من النظر قبله، وهو منه بسبيل، وإذا كان أبو حيان قد استطاع بما ذكره من مسالك منهجية أن يضبط علاقات الدرس اللغوي بعلوم القرآن فإن تلميذه السمين الحلبي قد استطاع أيضا أن يضبط علاقات علوم العربية بعضها ببعض داخل منظومة علوم القرآن. ويعد كتابه: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون أبرز ما وصل إليه النظر في هذا المستوى، وذلك أنه قصد بكتابه تجريد العلوم اللغوية من علوم القرآن وإعادة تركيبها بما يتناسب مع وظيفتها. وقد قد للكتاب بمقدمة وجيزة جامعة دالة على حسن معرفته بموقع هذه العلوم وتفاعلها فيما بينها.
وقد ذكر أن من أهم علوم القرآن وآكدها بعد تجويد ألفاظه بالتلاوة خمسة علوم، علم الإعراب وعلم التصريف وعلم اللغة وعلم المعاني وعلم البيان
وقد أحس بما آل إليه توظيف هذه العلوم عند المفسرين، فلاحظ أن التوظيف كان فيه قصور من جهات:
الجهة الأولى: عدم الاقتصار على هذه العلوم الخمسة في مصنف يجمعها، بل كان يضم إليها ذكر سبب النزول وذكر القصص وغير ذلك مما جرت عادة المفسرين بذكره.
الجهة الثانية: الاقتصار على علم واحد من هذه العلوم، وإغفال غيره من العلوم المتعلقة به، كالاقتصار على الإعراب دون التصريف أو البلاغة دون الإعراب. ونحو هذا.
الجهة الثالثة: ذكر الواضح البين الذي لا يحتاج للتنبيه عليه.
الجهة الرابعة: الاقتصار على الموضع المشكل بلفظ مختصر
ولتجاوز هذا القصور في الإعمال أصل أصلا كبيرا أسس به العلاقة بين هذه العلوم، وهذا الأصل هو أن هذه العلوم الخمسة "متجاذبة شديدة الاتصال بعضها ببعض لا يحصل للناظر في بعضها كبير فائدة بدون الاطلاع على باقيها. وعلى هذا الأصل اعتمد في توظيف هذه العلوم توظيفا قائما على المزج بينها وتوحيدها.
ومن ثم فإنه تلافى القصور بأمور ثلاثة:
الأول: جمع أطراف هذه العلوم آخذا من كل علم بالحظ الوافر.
الثاني: إذا عرضت قاعدة كلية من قواعد هذه العلوم أو ضابط لمسألة منتشرة الأطراف ذكر ذلك محررا له من كتب القوم ولا يذكر إلا ما هو المختار عند أهل تلك الصناعة.
الثالث: إذا ذكر مذهبا لأحد من أهل العلم فقد يحتمل هذا الكتاب ذكر دلائله والاعتراضات عليه والجواب عنه فيذكره، وقد لا يحتمل فيحيل على كتب ذلك العلم.
وقد حاول من خلال هذا التصور أن يضبط العلاقات الداخلية بين هذه العلوم الخمسة، متلافيا ما لاحظه من قصور في توظيفها واستثمارها عند المفسرين من خلال إعمال نسقي منهجي يرصد الخطاب في مستوى الإفراد ومستوى التركيب.
وبذلك يكون عمل أبي حيان في البحر المحيط والسمين الحلبي في الدر المصون، مثالا بارزا لما وصل إليه استثمار الدرس اللغوي في علوم القرآن.
ولا يخفى أن التأليف في علوم القرآن الآن ينبغي أن يولي وجهه نحو ضبط منهجية توظيف علوم القرآن لكونها تضبط نسق هذا العلم وعلاقات مفرداته بعضها مع بعض. وقد نبهوا على أصول جليلة وأمور دقيقة في منهجية التوظيف، أسهموا من خلالها في إغناء الدرس النحوي واللغوي. وقد كانت السمة المنهجية في التوظيف مراعاة عند المفسرين، بيد أنهم لم يتعرضوا لتجريد هذه السمات وتأطيرها نظريا، و"عدم تعرضهم لقانون التفسير لا يعني عدم اعتبارهم به".
ويمكن من خلال النظر في هذه الكتب الحديث عن أصول كبرى تضبط المنحى المنهجي لعلوم العربية في علوم القرآن. وتجيب عن أسئلة واردة في الباب، أهمها:
ما الضابط المنهجي المعتبر في عد علم من علوم العربية ضمن علوم القرآن؟
وما الضابط المنهجي في المسائل المنتقاة منه؟
وما الضابط المنهجي في الشروط التي ينبغي استحضارها عند استثمار هذه العلوم؟.
وهذه الأسئلة تحيل على معيار الاختيار الذي بموجبه يتم اختيار العلم أولا، ثم اختيار مسائله ثانيا، ثم اختيار طريقة استثماره ثالثا.
والرأي أن مادة الإجابة عن هذه الأسئلة مبثوتة في كتب علوم القرآن والتفسير، تحتاج لاستخراج وتأطير ملائم، وقد اجتهدت في ذلك على الوجه الذي أذكره بحول الله.
وذلك أن معيار الاختيار في المناحي الثلاثة كان قائما على أصول ثلاثة، كل أصل يراد منه ضبط منحى من تلك المناحي. وهذه الأصول الثلاثة ولنسمها بالقوانين، هي قانون الاحتياج وقانون المناسبة وقانون التوظيف.
ففي المنحى الأول وهو الضابط المنهجي المعتبر في عد علم من علوم العربية ضمن علوم القرآن. قرروا فيه أصلا عاما وقانونا جامعا، ولنسمه قانون الاحتياج. والتعبير بالاحتياج تعبير دقيق موف في دلالته على الغرض الذي يراد منه. إلا أن الاحتياج مفهوم عام ومعنى مبهم، إذ كل علم قد يدعي الاحتياج إليه في التفسير. لذلك ورد الاحتياج مقيدا بمفهوم آخر يصاحبه أحيانا وهو التوقف، والاحتياج إذا نظر إليه بقيد التوقف، كان معيارا ضابطا لكل معرفة يراد إدراجها في علوم القرآن، فيكون إدراج كل علم مبنيا على احتياج المفسر إليه وتوقف فهم الخطاب عليه. ومن ثم كان اعتراض المفسرين على بعض من أدرج علوما في التفسير بكونها لا يحتاج إليها لعدم توقف التفسير عليها.
والتوقف والاحتياج ألفاظ موضحة وعبارات دالة، تضبط مقدار المعرفة التي ينبغي استثمارها في التفسير وعلوم القرآن. ويمكن صياغة ذلك بقولنا: كل علم يحتاج إليه القرآن من جهة توقفه عليه في بيان المعنى فهو من علوم القرآن. وكل مسألة يقتصر منها على مقدار الحاجة من جهة ما يتوقف عليه توظيفها من الإفادة.
وأما المنحى الثاني وهو الضابط المنهجي في المسائل المنتقاة من علوم العربية: فقد قرروا فيه أصلا ولنسمه قانون المناسبة.
ومعناه أن يكون هذه المسائل مناسبة للوظيفة التي يستدعى لها.
وبناء على هذا فإن المنهج يقتضي أن لا يستدعى من علوم العربية إلا ما له مناسبة بالخطاب، ويخرج ما لا مناسبة له،
ومن صور المناسبة اعتراضهم على من توسع وذكر ما لا ينبغي ذكره في التفسير من الإعراب وذكر العلل النحوية والاحتجاج لها،
ومن صور المناسبة أن تكون المسألة المستدعاة من علوم العربية مقررة عند أهلها محررة عندهم، وليست قولا مرجوحا أو ضعيفا أو قال به من ليس متخصصا في علوم العربية، فلا يستشهد برأي مرجوح ولا غيره أقوى منه.
وهذا التناسب يضمن أمرين: الأول: حجم الاستثمار، والثاني: رتبة كل علم داخل النسق العام.
وأما المنحى الثالث: وهو الضابط المنهجي في الشروط التي ينبغي استحضارها عند استثمار هذه العلوم؟. فقد نبهوا على جمل من ذلك يمكن إدراجها تحت قانون جامع ولنسمه قانون التوظيف.
ومقتضى هذا القانون النظر في وجه إعمال المسائل اللغوية في التفسير، ويمكن الحديث هنا عن أربعة شروط للإعمال:
الشرط الأول: توسيع الإطار النظري.
الشرط الثاني: عدم الاقتصار على الدرس اللغوي وحده في التفسير.
الشرط الثالث: التخصص في هذا العلم أو اعتماد كلام أهل التخصص فيه.
الشرط الرابع: عدم التعرض للخلافيات في ذلك العلم وعزو ذلك لمظانه المؤلفة فيه.
وبناء على قانون الاحتياج والمناسبة والتوظيف، يمكن تأطير مباحث علوم العربية في علوم القرآن من جانب الوظيفة ومن جانب المنهج.
فيكون جانب الوظيفة قائما على أصل الاحتياج، وهذا الأصل يضبط نوع العلم الذي يوظف في علوم القرآن ومقدار ما يوظف منه. ويكون جانب المنهج قائما على أصل المناسبة. وهذا الأصل يضبط نسقية إعمال هذا العلم وتراتبيته مع غيره من العلوم.
فالاحتياج أصل في الاعتبار والمناسبة أصل في الاستثمار.
وهذه الأصول العامة تمثل آفاقا واعدة للدرس اللغوي في علوم القرآن. والمقترح في ختام هذا البحث، أن يعاد النظر في مؤلفات علوم القرآن تصورا وتبويبا.
فمن حيث التصور المؤطر لطبيعة هذه العلوم وما يستدعى منها ومقدار ما يحتاج من كل علم وما يتعلق بهذه من الأغراض، فإنه ينبغي التأصيل لها في مقدمات كتب علوم القرآن، ووضع تصور نظري لائتلاف هذه العلوم وتداخلها، بحيث يشتمل الكتاب على مقدمة نظرية ضابطة لمستويات التوظيف ومنهج الإعمال.
ومن حيث التبويب وترتيب المادة، ينبغي إعادة ترتيب مواد علوم القرآن بالنظر في أمرين:
الأول: جمع المسائل المنتمية إلى علم واحد، فتجمع مسائل النحو في علم النحو ومسائل البلاغة في علم البلاغة ونحو ذلك.
الثاني: ذكر ما يتقابل مع جهاتها، ونعني بالجهات هنا الموضوعات التي تنظر فيها هذه العلوم، فالمعجم موضوعه المفردة من حيث دلالتها العامة، والصرف موضوعه النظر في بنية الكلمة والاشتقاق موضوعه النظر في أنساب المعاني الكامنة في الصيغ والنحو موضوعه التراكيب والبلاغة موضوعها النظر في ملاءمة التراكيب لمقتضى المقام.
ويمكن بناء على هذا أن تكون علوم القرآن مرتبة على حسب المستويات، ففي مستوى المفردة، نستحضر المعجم والصرف، وعلى مستوى التراكيب وعلى مستوى الدلالة وعلى مستوى التداول وعلى مستوى الصوت. ولا ينبغي أن يتم ترتيب هذه العلوم بمعزل عن الترتيب العام، فتدخل في قسم المفردة علوم الأداء قراءة ورسما وضبطا وصوتا، وفي قسم التركيب علوم أخرى كالفقه والأصلين وما يحتاج إليه المفسر. وعندما يتم استدعاء هذه المسائل من علومها فإنه يعاد تهذيبها بما يتناسب مع وظيفتها وموقعها الجديد.
والله أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين.