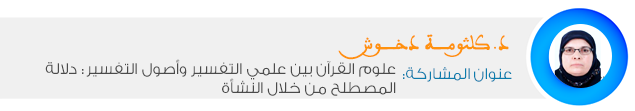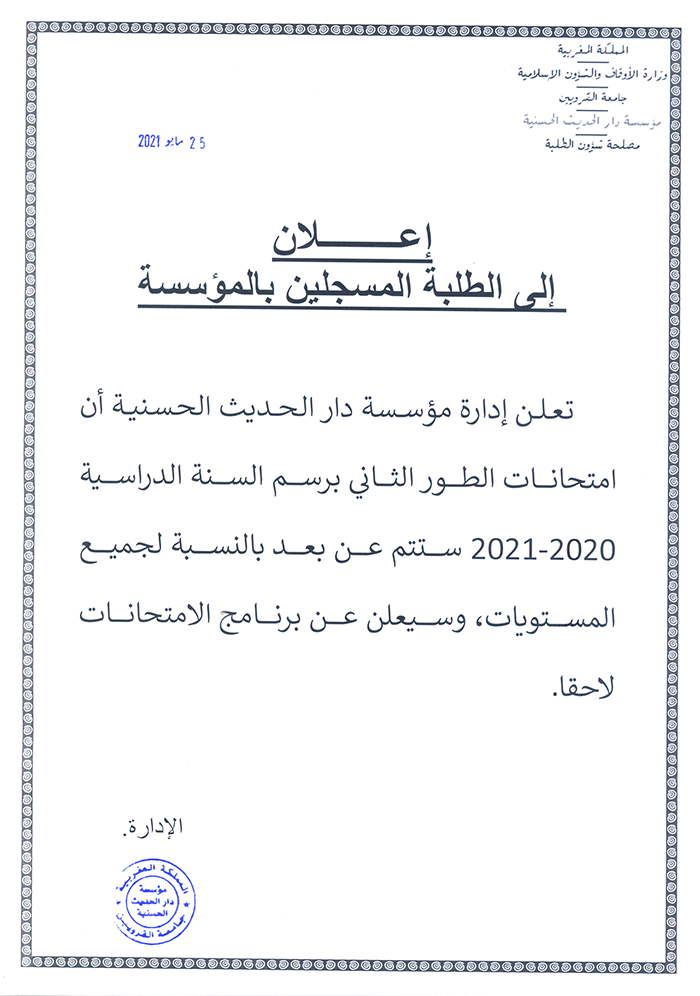المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد: إن كون تدوين علوم أوّل الأصلين (القرآن الكريم) تأخر عن تدوين ثانيهما (السنة) يلمح إلى فروق بين مفهومي المسمَّيَينِ ، وأحاول استكشاف تلك الفروق من خلال عدسة القرن الرابع الهجري. كان القرن الرابع الهجري عصر تشتيت ودمج في آن واحد: تشتيت في المجال السياسي، ودمج في مجال العلوم الإسلامية. فلنبدأ ببيان هاتين الظاهرتين باختصار.
الوضع السياسي في القرن الرابع الهجري
امتد العالم الإسلامي في القرن الرابع امتدادا واسعا ، غير أن الخليفة العباسي كان رئيسا رمزيا فقط، إذ كانت القوة التنفيذية بأيدي ملوك الطوائف الذين كانوا قد بايعوا الخليفة رمزيا. فالدولة الإسلامية تم تفريقها إلى دويلات: الغزنوية، وبنو بويه، وبنو الخلفاء الأندلسيون، والأخشيديون. وقد استولى الفاطميون على مناطق من شمال إفريقيا،، وانفصل عن هؤلاء فرقة القرامطة وعاثوا في الأرض فسادا. وفي هذا القرن أيضا أصيبت أراضي المسلمين بهجمات الروم، وفي المقايل أخذت جيوش المسلمين تستولي على بعض الأراضي الجديدة . ,وأحيانا كانت تقع مشابكات بين السنة والشيعة. وعلى الرغم من هذه السلبيات، فإن الحالة الإقتصادية كانت مريحة، مما ساعد على ظهور نهضة وازدهار في العلوم الإسلامية، فلنبين ذلك.
الوضع العلمي في القرن الرابع الهجري
يعتبر القرن الرابع طور النضوج والاستقرار للعلوم الإسلامية عموما، إذ فيه تمت تطورات عدة لها علاقة بعلوم القرآن.
1- ظهور مدارس عقدية
في مستهلّ هذا القرن ظهر أبو الحسن الأشعري (م324هـ) بالبصرة وأبو منصور الماتريدي (م333هـ) بخراسان، وهما يعتبران مؤسسَي مذهبي الأشاعرة والماتريدية السُّنِّيَّينِ. والمعتزلة (وهم أقدم مدرسة كلامية) ما زالوا موجودين، وإن كانت شوكتهم اضمحلت بعد رفع المحنة. وكان لهذه المذاهب الكلامية الثلاثة تأثير قوي على زرع بذور علوم القرآن، خصوصا في مجالين (هما: أصول الفقه، والرد على مدعي تحريف القرآن).
والقرن الرابع يعدّ طورا محوريا بالنسبة للإمامية الاثني عشرية. فإن عام 329هـ يمثل ابتداء زمن "الغيبة الكبرى"، أي: غَياب إمامهم الثاني عشر (المهدي) عن الاتصال بهذا العالم. وإن هذا الحادث قد شجع علماءهم على العناية بتدوين علوم مذهبهم، إذ لم يعد بإمكانهم مراجعة الإمام ("المعصوم") في المسائل الدينية. والمذهب الزيدي أيضا نما وازدهر في القرن الرابع، بعد إنشاء دولتهم في اليمن على يد الإمام الهادي (م295هـ).
2- الحوارات والمجادلات حول تحريف القرآن.
ظهرت دعوى ذهاب بعض القرآن في صفوف الشيعة الإمامية في أواخر القرن الثالث، وذلك في فترة بدأ الفكر المعتزلي يتسرب في تفكير الإمامية. فصارت القضية تناقش في الأوساط العلمية في بغداد، وشارك في تلك المناقشات الساخنة أمثال القاضي عبد الحبار المعتزلي، والقاضي الباقلاني الأشعري، والشيخ المفيد الإمامي. وكان لهذه المجادلات تأثير ملموس على علوم القرآن.
3- تدوين أصول الفقه
شاهد القرن الرابع نشاطا قويا في هذا المجال، فظهرت كتب أصولية للجصاص الحنفي (م370هـ)، وابن القصار المالكي (م397هـ)، حتى تبلور أصول الفقه بجهود القاضي الباقلاني، م403هـ وغيره.
4- علوم الحديث
إن تدوين المصنفات الجامعة للحديث كان قد تمّ في القرن الثالث في العالم السني، مما سهّل البناء عليها في مجالات أخرى كالعقائد، والفقه، وعلوم القرآن. وخرجت تأليفات تحاول استقصاء قواعد علوم الحديث (كمعرفة علوم الحديث للحاكم، م405 هـ). أما في العالم الشيعي الإمامي، فإن حركة تدوين الحديث ابتدأت في هذا القرن (الرابع) – لما بينت سابقا – على يد أمثال الكليني (م329هـ) والصدوق (م381هـ).
5- علوم اللغة
ومن أهم تطورات الدراسات اللغوية في القرن الرابع: تظريات الإعجاز (على يد أمثال الرماني المعتزلي والباقلاني الأشعري)، والتي أصبحت قضية مهمة في علوم القرآن. وتم تأسيس أصول النحو على يد ابن السراج ، م316هـ.
6- تطور علم التفسير
شاهد القرن الرابع بداية حركة التحقيق في التفسير بالمأثور، ونشأة حركة التفسير بالرأي والتفسير الصوفي الإشاري . كما نرى أيضا عددا من المفسرين يجعلون لكتبهم مقدمات يبينون فيها مسائل من علوم القرآن، ويعدّ هذا مرحلة مهمة في تطور علوم القرآن.
6- تدوين القراءات
يعتبر أبو بكر بن مجاهد (م 324ه) الفاعل الرئيسي في هذا المجال، لكونه أول من وضع قوانين أو ضوابط منهجية للقراءة المقبولة. وفي هذا القرن أيضا ظهرت أول قصيدة (حسب ما وصل إلينا) في التجويدـ هي قصيدة أبي مزاحم الخاقاني (م325هـ).
7- التصوف
تحول مجرى التصوف بعد إعدام الحلاج (م309هـ)، فجنح الكثير من الصوفية خاصة إلى علم الكلام كضمان من الضلال، وقوي شعور الحذر في صفوف المسلمين عامة. ومن المرجح أن هذا الحذر، كان له تأثير على مدى مقبولية التفاسير الصوفية الإشارية في صفوف أهل السنة.
وقفة مع كتب أصناف العلوم وبناء على هذه التطورات الضخمة في العلوم المختلفة، وتحت تأثير علوم اليونان العقلية، أخذ بعض علماء البلاد الإسلامية يؤلفون أيضاً كتبا في تصنيف (أصناف) العلوم. والذي يهمنا عن هذه المصنفات هو مدى اهتمامها بذكر علوم القرآن وعلوم الحديث ضمن أصناف العلوم الإسلامية. وقد اخترت مصنفات الفارابي، والعامري، وابن النديم، والخوارزمي، كنماذج لهذه الدراسة.
فمعظم هؤلاء المصنفين لم يعتبروا علمي القرآن والحديث صنفين مستقلين بين أصناف العلوم الإخرى، ويمكن تعليل ذلك من جانبين:
أولا: أن اختيار أقسام للأنظمة التصنيفية أمر غير موضوعي، فقد يعتبر شخص علوم الحديث (مثلا) فنا مستقلا، بينما يرى آخر ضمها في صنف الفقه، لكونها تخدمه.
ثانيا: أن علوم القرآن في هذه الفترة كان لا يزال متناثرا في كتب متفرقة، بخلاف علم مصطلح الحديث، الذي كان أصبح بالفعل فنّا مستقلا. ولكن: لماذا اختلف مسارَي هذين الفنين، وما أثر ذلك في تطور علوم القرآن ؟
الفروق بين علوم الحديث وعلوم القرآن
1- من حيث الغرض الأصلي من كل علم
كان الغرض الأصلي لوضع علوم الحديث الإلمام بدرجة الصحة التي هي عبارة عن مدى مقبولية الخبر وصلاحيته لإثبات حكم شرعي. فكتاب ابن الصلاح، مثلا، الذي يعتبر من أمهات مراجع هذا العلم، يحتوي على 65 باباً، منها57 باباً في بيان أقسام الأخبار، والجرح والتعديل. فالحاجة إلى التمييز بين الأخبار حفزت وعجلت على ظهور علم الحديث وذلك في فترة مبكرة (بالنسبة لعلوم القرآن)، بينما القرآن لم يكن بحاجة إلى مثل ذلك التثبيت، إذ كان نصه (الذي تضمنه الرسم العثماني) من المسلَّمات لدى كافة المسلمين. فالقرآن يتعبد بتلاوته، ويعتني الفقهاء بالاستنباط منه. أما كونه يحتاج إلى دراسة في ذاته فلا. نعم، وقعت اختلافات حول مدى مقبولية القراءات المنقولة، ومعنى الأحرف السبعة، فكتب في ذلك أمثال ابن مجاهد ومكي القيسي. ثم عند ظهور الجهود في أصول الفقه في القرن الرابع، تعرض الأصوليون لمسائل أخرى جديدة لها علاقة بالقرآن، كحدّ القرآن (أي: تعريفه). ويبدو أن الزركشي (الأصولي البارز) أول من ضم المسائل الأصولية إلى علوم القرآن.
ومن تطورات القرن الرابع التي لها علاقة بعلوم القرآن:
- فكرة تحريف القرآن، ولعلها كانت الحافز على وصف نقل القرآن بمصطلحات استعملت أولاً في مجال علم الحديث.
- نظريات إعجاز القرآن، وكان تاثيره على علوم القرآن ذا شقين: مباشر (فقدعقد السيوطي لإعجاز القرآن بابا مستقلا في الإتقان )، وغير مباشر (إذ أثّرت دراسات الإعجاز على تطور علوم البلاغة التي ضمّت إلى علوم القرآن أيضا).
2- من حيث المصطلحات المستعملة في كل علم
قلّت المصطلحات في علوم القرآن بالنسبة لعلوم الحديث. وذلك أن مصطلحات المحدثين أغلبها تتعلق بأقسام الحديث من حيث اتصال الإسناد، وقوّته، إلى غير ذلك. أما المصطلحات في علوم القرآن فمعظمها تتعلق بأقسام دلالات الكلام، وهي مستمدة من علم أصول الفقه، وإن كتب علوم الحديث لا تتعرض لهذه المسائل كما سبق التنبيه عليه.
نعم، حاول عدد من العلماء دمج مصطلحات المحدثين ومنهجهم في دراسة القرآن. فجاء أبو بكر ابن مجاهد (324هـ) وجعل صحة إسناد القراءات أحد معايير مقبوليتها. وأبو عمرو الداني (م444هـ) يذيل تراجم مشاهير القراء بأقوال نقّاد رواة الحديث.وتابع ابنَ مجاهد في تطوير مفهوم الإسناد القرآني وتقسيماته آخرون إلى أن جاء السيوطي (م911هـ) الذي كان مولعا بالمقارنة بين علوم الحديث وعلوم القرآن. فقد زاد السيوطي قسمين إلى أقسام القراءات القرآنية من حيث السند لم يسبق إليهما - الموضوع والمدرج - وهما مصطلحان استقاهما من المحدثين. وابتكر السيوطي في الإتقان بابا آخر مستقى من علوم الحديث، وهو "معرفة العالي والنازل".
ولا بأس بالتلاقح بين العلوم، ولا مشاحة في الاصطلاح. بيد أنه ينبغي أن نتنبه إلى أن هناك فرق جوهري بين نقل القرآن ونقل الأحاديث، وأن تجاهل هذا الفرق يؤدي ليس فقط إلى خلط في المفاهيم، بل ربما إلى الشك أو الطعن في القرآن. فالقرآن الكريم، منذ بداية الإسلام، كان نواة مركزية للدين وكان مدار نقله على الشهرة المستغنية عن طلب الإسناد. وبهذا تندفع شبهتان: أحدهما: كون بعض أئمة القراءة نُقل تضعيفهم عن نقاد الحديث، والثانية: كون أسانيد القراءات السبع آحادية في الطبقات المبكرة (بين الأئمة السبع والنبي صلى الله عليه وسلم).
وقفة مع "كتب المصاحف"
يبدو أن عناية علماء الحديث، بعد تدوين أمهات الكتب الجامعة، توجهت إلى تصنيف "الأجزاء الحديثية" التي هي عبارة عن جمع الأحاديث في موضوع خاص، سواء كان أخلاقيا، أو عقائديا أو فقهيا. وهناك نوع منها له علاقة مباشرة بعلوم القرآن، بل يعتبر من نواة علوم القرآن:كتب المصاحف. ظهر عدد من كتب المصاحف في القرن الرابع، لكن كتاب ابن أبي داود(م316هـ) هو الوحيد الذي وصل إلبنا. وكتابه عبارة عن 821 مرويات (بأسانيدها) مرتبة على أبواب تشمل مواضيع جمع القرآن، واختلاف مصاحف الصحابة، وخطوط المصحف، وعدد من المسائل الفقهية المتعلقة بالمصحف. وأنا أرى أن كتاب المصاحف هذا ليس مجرد مثال للأجزاء الحديثية، بل يمكن اعتباره من أوائل المحاولات لتدوين علوم القرآن، فقد تعرض المصنف (كما رأينا) لمعالجة أكثر من نوع من أنواع علوم القرآن. ويبدو أن كتاب المصاحف ممثل عن الحالة الراهنة للبيئة العلمية في القرن الرابع الهجري من ناحية الجنوح إلى التفكير الذاتي والتفكير في "الصورة الأكبر" للعلوم الإسلامية والذي أدى أيضا إلى بداية التصنيف في أنواع العلوم. ولعل الكتاب يعكس أيضا الاختلافات السائدة حول حجية مصحف عثمان، وحول تحريف القرآن.
القسم الإحصائي من البحث
بناء على ما تقدم، من كون القرن الرابع طورا مهما في تاريخ علوم القرآن، فقد قمت بتحليل إحصائي لكتاب الإتقان للسيوطي، بغية اكتشاف مدى اعتماد مادة كتابه على هذا القرن (الرابع): من حيث العلوم التي تعامل معها، ومن حيث الأعلام الذين نقل عنهم.
النتائج
1- محتويات أبواب الإتقان من حيث المجالات
تؤكد الإحصاءات أن أكبر جزء من مادة علوم القرآن مستقى من الأحاديث. ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين: طبيعة علوم القرآن كعلم مبناه على النقل، وسعة معرفة السيوطي بالروايات المنقولة عن النبي ﷺ والسلف.
2- الأعلام المنقولة عنهم حسب التاريخ
تؤكد الإحصاءات أن أعلام القرن الرابع أدوا دورا مهما في كتاب الإتقان من حيث عددهم ومن حيث ما نقل عنهم.
3- أبرز الأعلام في كتاب الإتقان
خلاصة
يستخلص أهم نتائج البحث في النقاط التالية:
1. إن القرن الرابع الهجري عصر نضج العلوم وتدوينها بشكل عام. لكن لم يتحقق تدوين علوم القرآن فيها، بخلاف علوم الحديث، لفروق بين الفنَّينِ (من حيث الغرض الأصلي من كل علم، ومن حيث المصطلحات المستعملة في كل علم).
2. ومن الممكن أن نعدّ "كتب المصاحف" نقطة اتصال بين علوم الحديث وعلوم القرآن، ومحاولة مبكرة لتدون علوم القرآن.
3. وعلى الرغم من أن تدوين علوم القرآن لم بنضج في هذه الفترة، فإن القرن الرابع قد أدى دورا محوريا في تاريخ علوم القرآن، إذ فيه تمت تطورات في علوم شتى مهدت لرجل متعدد جوانب ثقافته، مولع بالمقارنة بين علوم الحديث وعلوم القرآن (هو جلال الدين السيوطي) أن يجمع تلك الأشتات ويزيد على جهود سابقيه، ليُخرج للعالم كتاب الإتقان الذي يمثل ذروة في هذا المجال.
4. وأكدت التحليلات الإحصائية أن علماء القرن الرابع لهم دور بارز في كتاب الإتقان.
وفي الختام لي كلمة أخيرة. يبدو أن بغية السيوطي، في تأليف كتاب الإتقان، كانت ذا شقين:
أ - ابتكار كتاب شامل في علوم القرآن يضاهي أمهات الكتب في علوم الحديث."
ب - حفظ التراث ونقله للأجيال القادمة في صورة مرتبة منظمة، وإن سعة اطلاع السيوطي منحت لكتابه مكانة رواج وقبول وشهرة.
وكون منهج السيوطي يركز على النقل هو السبب الذي جعل كتابه يعكس أهمية القرن الرابع في تاريخ تأصيل علوم القرآ